استراتيجيات البناء في قصيدة (خرافة) ( 1 )
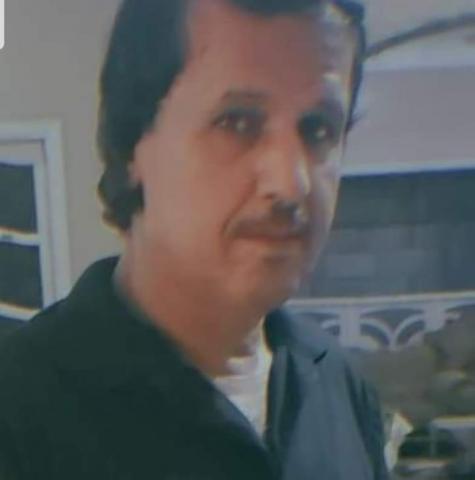

(عبد القادر عيد عياد) من أبرز شعراء سيناء منذ الثمانينات حتى هذا الآن الذي يشهد باستمرارية عطائه الفني المتنوع بين الشعر الفصيح – تفعيلة ونثرا – وبين الشعر العامي بلهجة المدينة، وربما امتدت سلسلة إبداعه إلى الشعر النبطي (البدوي) الذي يبدع فيه إبداعا مخالفا لتراث البادية، في اللفظ والشكل الفني.
هذا على مستوى الشكل. أما على مستوى الأداء الفني؛ فإن عبد القادر يوظف عديدا من الآليات الفنية التي نرى أنها تجعل القول خطابا شعريا غنيا بقيم الفن. فمن آلياته (الرمز) الذي يُعد (ظاهرة أسلوبية) وركيزة بنائية في كثير من منجزه الشعري، وهو ما نتتبعه في قصيدة الجميلة: "خرافة". ولكن بعد أن نلم إلمامة سريعة بطبيعة الرمز.
( 2 )
الرمز علامة لغوية تعطي مدلولا أوليا، وهذا المدلول الأولي الحرفي الواضح – الذي هو أصل الرمز – يتطلع هو أيضا إلى مدلول ثان، وربما ثالث، وربما إلى حد لا ينضب أبدا، وفق قدرة المتلقي على التأويل، ووفق ما يحتمل الرمز نفسه ومدى اتساع دائرته؛ فإن الرمز هو حركة المعنى الأولي الذي يجعلنا نسهم في المعنى الكامن، أو المعاني الكامنة، دون تكلف أو شطط. فلننظر في رموز عبد القادر من خلال قصيدته.
( 3 )
1- عصر الخرافة انتهى/ وما زلت حدوتي/ ليه تعلني المنتهى/ لما انتي حددتي
2- باستسمحك واعترف/ كلمة ب أقولها لك/ أنا لو معاكي اختلف/ لازم ح اكون هالك
3- ليه ردنا بنعلنه/ للعنف ان ندفع/ الحق ما اجبنه/ لو ناخده بالمدفع
4- مدفع وبنصوبه/ منا ع بعضينا/ ايه اللي ح انصوبه/ لما الغلط فينا
5- مين علمك يا جمل/ وانت الصبور تعند/ الشدة لا تحتمل/ إلا بأن نعي ند
6- والند في المعترك/ نحمل لك همومك/ ونرد ما يعترك/ فيفز مهمومك
7- مهموك اللي طفا/ همه على الساحة/ والساحة متستفة/ أشكالها سفاحة
8- بيشدوا ويشدّدوا/ وبفكر متطرف/ وبيعلنونا عدو/ م العقل متخلف
9- كل القلوب والملل/ كرهانة أمثالهم/ ومربيين العلل/ من كتر أفعالهم
10- إرهاب ورا بلطجة/ والقتل علانية/ اللعبة متدبلجة/ والرك ع النية
11- النية متبيتة/ ان احنا نتهمش/ والخطة متثبتة/ للجحش يتكلبش
12- الصبر منه اختشى/ اللي ظلم ناسي/ بالعنف والدروشة/ لجم لي انفاسي
13- دلوقت ب يضلني/ من بعد اعجازي/ يفضحني ويذلني/ ويهد انجازي
14- يا سينا ما اطهرك/ وانتي خطى موسى/ ترابك بيطهرك/ والأم محروسة
15- لما العيون ارتوت/ من شطك النخلي/ ليه القلوب اكتوت/ بتشدنا نخلي
16- من يرضى ان تحزني/ عمره ما كان ليكي/ الظلم لو هزني/ العدل يحميكي
17- اللي عليكي افترى/ واحد أكيد غيري/ بصي لي يا هل ترى/ الغدر من سيري
18- أحكي لك ايه عني/ وانتي اللي عارفاني/ مستنية مني/ اني اموت تاني
19- راح اموت لك ان يعجبك/ ستين تلاف موتة/ وح ارد من يحجبك/ لتكوني حدوتة
20- انا اللي مستأمنك/ عمري يا اغلى سينين/ وانا اللي في مأمنك/ يا عمري مت سنين
21- فاكرة الهرم أذ بدا/ طوبة على طوبة/ كنتي على المبتدا/ والذاكرة معطوبة
22- واما الفتوح ايسرت/ مين اللي كان فيها/ وفرحتي لمن سرت/ فيكي صواريها
23- فاكراني لما بنت/ أيدي مساعيدك/ كتب التاريخ اعلنت/ ذاك المسا عيدك
24- في النكسة مين اللي انا/ قرب مسح دمعك/ واتصدى للهيمنة/ ولا حد كان سامعك
25- واما العدو انصرع/ يجري على ارضك/ قلبي كشوكة انزرع/ يتلقى عن عرضك
26- عشنا سوى بنحوش/ ونرد زلزاله/ في الجد كنا وحوش/ لما نزلنا له
27- واكتوبر اللي اتعرف/ اسمه على اسمك/ في النصر ليا الشرف/ اني اكون وسمك
28- أيدي على مدفعك/ مع كل اجنادك/ والحب كان يدفعك/ من كل اولادك
29- العجز ما ذلني/ في عهدك الخاسي/ وف كل ماذا الا اني/ محسوبة انفاسي
30- في الثورة كنت القدر/ على كل من ردك/ تتحدي بيّ الخطر/ وانا صبرك وردك
( 4 )
بُنيت القصيدة وفق تنظيم دقيق أحكم العلاقة بين عناصرها البنائية، وقد جاء هذا التنظيم على هيئة الاستراتيجية المقطعية التي بلغت ثلاثين مقطعا، في كل مقطع أربع أسطر وقافيتان. وهذه الاستراتيجية البنائية تستدعي (قراءة استرجاعية) تجعل المتلقي قادرا على تعديل مواقفه كلما تقدم زمنيا وبصريا في اتصاله بالنص، وكلما استكشف أن هذه الاستراتيجية لا تقدم النص دفعة واحدة، بل تقدمه في صورة استرسال مقطعي بصري يقترن باسترسال زمني، ويرسم حقولا بصرية ذات تأثير فعال في عملية التلقي، ومصدر هذا التأثير هو هذه العلاقة الجدلية بين المقطع المقروء الآن (الحقل البصري الآني) وبين مقطع تأخر زمنيا وبصريا إلى وراء، تاركا أصداءه الشعورية والفكرية على وعي المتلقي، وعلى فعل القراءة، فضلا عما يتولد في نفس القارئ من توتر في انتظار مقطع آخر يقدم مشهدا بصريا جديدا، مرادفا لزمن قراءة مستقبل؛ لتتحقق أفضل دينامية قرائية بفضل استراتيجية بناء المقاطع. فكيف صنع الشاعر هذه الاستراتيجية المحكمة؟
( 5 )
واضح أن القصيدة غنائية تصور موقفا عاطفيا عاما نحو سيناء، تتفرع منه عواطف جزيئة متجانسة ومتكاملة؛ فكان كل مقطع هو بمنزلة أفق شعوري يلتحم بالآفاق الشعورية الأخرى، ويخلق للقصيدة جوا انفعاليا متآزرا.
وقد ساعد البناء اللغوي بدوره على إحكام نسيج القصيدة؛ فقد ينتهي المقطع بكلمة هي نفسها بداية مقطع جديد، ومثاله المقاطع من الرابع إلى السادس، وهو تكتيك فني يحقق شروط الاستراتيجية المقطعية، ويضمن للقصيدة تماسكها وتلاحمها.
فكريا، إذا كانت بعض المقاطع تصور أفكارا جزئية تتقاطع مع الفكرة العامة وتوازيها، أو تلقي عليها ضوءا شعوريا وفكريا يزيدها جلاء، ويحقق للمتلقي الإشباع الشعوري والدلالي؛ فإن بعضا آخر جاء مصورا لفكرة جزئية واحدة تستغرق أكثر من مقطع، مثل المقاطع من السابع إلى العاشر؛ فتبدّت القصيدة كلها قطعة فنية متلاحمة ومتكاملة.
( 6 )
أما على مستوى البناء الفني؛ فإننا نجد فيه استراتيجيتين. الأولى هي مستوى الخطاب المباشر (من 6 إلى 11 مثلا)، وسَوق المسوغات العاطفية لإثبات وتبرئة الذات (من 16 إلى 20، و28مثلا)، والمسوغات التاريخية (من 21 إلى آخر القصيدة). وهذه الخطابية واللغة التقريرية، وشبه التقريرية، وجد الشاعر نفسه متورطا فيها بسبب الاستراتيجية التي انطلق منها، استراتيجية الباعث والهدف الذي حفزه على التعبير، وهي استراتيجية الدفاع ضد الاتهام، والثبات ضد الرحيل، استراتيجية تبحث عن تحقيق الذات في مقابل ما يحيط بها من عوامل الفناء المعنوي والمادي؛ فكانت النتيجة أن الشاعر راعى حالة المتلقي (مقتضى الحال) أكثر مما راعى السياق الفني وقيم الشعر. وهي نتيجة طبيعية، وربما نلتمس لها ذريعة من كون الشاعر يخاطب العقل (المتكلبش) من أجل أن يستجيب ويتفاعل مع هذه (المرافعة الأدبية)؛ فحاول أن يخلق لدى هذا المخاطَب نوعا من التضامن والتجاوب عن طريق ما يسميه (إيزر) "البنية النصية المحايثة للمتلقي" التي تعني جملة من التوجهات والتوجيهات التي يخلقها النص طلبا للتأثير في المتلقي، واستدرارا لتفاعله وتعاطفه.
وإن كان للشاعر شيء من عُذر؛ فإن بعض الإجراءات الفنية جعلته عذرا مقنعا، ومن هذه الإجراءات (التجانس الموسيقي) الذي تكرر كثيرا، مثل: حدوتي/ حددتي، أقولها لك/ هالك، بنصوبه/ حنصوبه. وهو ما يصنع إيقاعا لافتا يكسر حدة التعبيرات المباشرة.
أما المستوى الثاني الذي يمازج الأول؛ فهو استراتيجية المجاز. وهنا تظهر شخصية الشاعر الكبير في استخدام الصورة بأنواعها كافة، وفي تكثيف بعضها وتعميقه حتى غدت رمزا، وحتى غدا الرمز نفسه استراتيجية بارزة من استراتيجيات بناء النص. وهو ما نسعى في تبيانه.
( 7 )
"عصر الخرافة انتهى/ وما زلتي حدّوتي"! تردّ لنا الرموز عصر البراءة؛ فنحن ندخل في الرمزية عندما يكون موتنا وراءنا وطفولتنا أمامنا، وفق (ريكور). والشاعر هنا يفر من حالة الموت التي تعيشها سيناء، إلى مرحلة الحياة الطفولية البريئة. الشاعر هنا يستثمر الإيحاء الثري للحكاية الخرافة الشعبية، وما تثيره في نفوسنا من عالم سحري مليء بالتشويق المثير، وما يستحضره من عهد الطفولة الجميل البريء، وما يرسم من بطولات ينتصر الخير فيها على الشر، إلى آفاق لا تنتهي من التأويلات الحميمة التي تصور سيناء خرافة محبوبة جميلة شائقة، لم تخل يوما من مغامرات وأخطار. وعبد القادر إذ يداعب إحساسنا الجمعي بهذا الرمز الخرافي؛ لا يكتفي بأن ينقل إلينا تجربته، بل إنه يشركنا في الإحساس بها، من حيث ندري، أو لا ندري.
ثم يقول في موضع آخر: "يا سينا ما أطهرك/ وأنتي خُطى موسى". هنا صورة تشبيهية، توضح الفرق الدقيق والعميق بين المجاز الذي لا يرقى إلى مستوى الرمز، وبين الرمز الفياض بالدلالات.
فهذه صورة تجاوزت حدود الدلالة الحسية الضيقة، واعتمدت على الإيحاء الرحب لا على سرد الأفكار وبسطها، لذلك ارتقت إلى مرتبة الرمز؛ لأنها ليست مجرد وسيلة للتعبير غير المباشر كما شأن التعبير المجازي التقليدي، بل هي – في الحقيقة – ليست إلا قرينة مجازية تساعد على الوصول إلى المقصود الرمزي وما يثيره من نواحٍ نفسية وفكرية تختلف من قارئ إلى آخر، وربما تغاير ما كان يقصد إليه الشاعر نفسه، وكما قيل: لا رمز دون تأويل، ولا تأويل دون اعتراض!
خُطى موسى، تاريخيا، وثيقة الصلة بسيناء. وهي، رمزيا، دقيقة التعبير عن سيناء. خطى موسى، في سيناء، ترمز إلى ذلك السائر الخائف المترقب، لا يدري من أين يؤتى وقد تهدده طالبو الثأر يطلبون دمه. ثم هي خُطى الباحث عن قبس يحقق له الدفء والطمأنينة، وخطى الباحث في ليل الصحراء عن "هدى" لدى نار آناسها. وهنا المفارقة المدهشة بين نار سيناء التي ارتقت بموسى إلى أسمى منزلة، منزلة الكليم، ونار سيناء – أيضا – التي هبطت بالحياة إلى منزلة الفناء، منزلة المنبوذ الرجيم، و"النية متبيتة إن إحنا نتهمّش/ والخطة متثبّتة للجحش يتكلبش".
على أن خطى موسى لم تتوقف بعد؛ فما زال أمامه خروج آخر مقرون بخوف أشد، وموازٍ لخوف يعقب خوف يمر على سيناء، وربما لبث فيها سنين عددا. وما زالت خُطى موسى تسير نحو (التيه)، والتيه سيناوي، تاريخيا، وحاضرا. تيه وتطلع إلى المدينة المقدسة الطاهرة – "يا سينا ما أطهرك" – تطلع يحتاج إلى معجزة (يوشع) حيث تعاطفت معه الشمس، وامتد له النهار، حتى انتصر الخير على الشر، وانتهى عصر "مدفع وبنصوبه/ منا ع بعضينا/ ايه اللي ح نصوبه/ لما الغلط فينا".
هذا هو الرمز الثرّ الثري الذي يحيل إلى سُدُم من الدلالات اللانهائية، لولا أن عبد القادر قيده بعبارة ضيقة وخطابية مباشرة: "يا سينا ما أطهرك"؛ فإن خطى موسى ثيمة أدبية تبدأ من طهارة النبي، لكنها لا تقف عند حد قريب.
وقد يستحضر عبد القادر حدثا تاريخيا هو (الفتح الإسلامي)؛ رمزا للعدل والنور والحرية، ضد الظلم والظلام، ضد فئة "بيشدوا ويشددوا/ وبفكر متطرف/ وبيحسبونا العدو/ م العقل متخلف"! يقول: "وأما الفتوح أيسرت/ مين اللي كان فيها"! وهي إشارة رمزية لما أثبته المؤرخون من أن قبائل سيناء أسهمت في الفتح وفي تحرير المحروسة من حكم الرومان، إشارة فيها من الدفاع عن سيناء أكثر مما فيها من تعميق الرمز وإثرائه، وإن كان يُحسب للشاعر أنه استحضر حدثا تاريخيا قديما للكشف عن حالة شعورية يعيشها ويعانيها الآن. ثم يمتد هذا الرمز نفسه في خطاب حميم فيه أسى وحزن، وفيه فخر المتألم، يقول: "فاكراني لما بنت/ أيدي مساعيدك/ كتب التاريخ أعلنت/ ذاك المسا عيدك"! فالشاعر هنا يستحضر المقولة التاريخية: "المسا عيد"، ثم يصنع منها تعبيرا موفقا إلى أقصى حد؛ فهو يذكّر من نسي، وينسب البناء إلى نفسه، إلى يده؛ فهو مَن يبني ولا يهدم، أما من ينكر؛ فليسأل كتب التاريخ التي تشهد بأنني – والكلام للشاعر – بانٍ اعتاد أن يبني من المساء عيدا، وهي صيغة رمزية تحيل إلى رغبة الذات الشاعرة في أن يستحيل هذا المساء الذي طال، عيدا نصنعه بأيدينا جميعا؛ لنشعر بلذة الإنجاز، ومتعة النجاح، وانتصار العيد على المساء، فعسى – يا سيناء، قريبا – أن يكون المسا عيدك!
( 8 )
إن عبد القادر قادر على استحضار الرمز المناسب، وقادر على استثماره ليوحي إيحاء شعوريا قويا، وليفيض بدلالات تتجاوز بكفاءة حدود المواضعة الدلالية للألفاظ، وتتجاوز الدلالة العقلية للرمز التاريخي، ذلك بأن خلق هذه الرموز خلقا آخر، وبث فيها من روح تجربته.
لكن استراتيجية الهدف الذي انطلقت منه القصيدة قعدت ببعض الرموز عن أداء دورها الفني الممتع والمقنع. خذ مثالا هذه الرموز: الجمل – الدروشة – الهرم – أكتوبر؛ تجد الشاعر مَرّ بها على عجل، فحصرها السياق عددا، ولم يحط بها خُبرا؛ فلم يُشر إلى إيحائها العاطفي ولا إلى مغزاها الدلالي، ولم يضف إليها شيئا من عند نفسه، بل ظلت رموزا تاريخية لا تحمل إلا دلالتها الأولية الشائعة بين عامة الناس.
نقول هذا؛ لأن عبد القادر قادر – نكرر – على الإبداع والتفنن، وآية ذلك أن نقارن بين رمز النخل الوارد في قصيدته هذه، وبين الرمز نفسه في قصيدته الأخرى "ما زلت لون البحر" التي يقول فيها:
"ما عاد ينزعك التوجّسُ/ فانتسابك للنخيل/ يعيد موثقة التئامك... وامتداد التين والزيتون.."
هذا هو الشاعر، وهذا هو استثمار الرمز الذي يتخطّى ما تعارف عليه العامة من أن النخيل رمز الجمال على شواطئ سيناء، ومن أن التين والزيتون رمزان للخير والنماء والقداسة القرآنية، الاستثمار الذي تخطى أصل الرمز ليضيف إليه من تجربة الشاعر دلالة جديدة تتمثل في عمق "انتسابك" و"امتداد" وجودك بامتداد عمر النخل والتين والزيتون، و"طور سينين" الذي يُستدعى بضرورة السياق في هذا الموقف الذي أجبر الشاعر على البحث عن إثبات الذات تاريخيا ووطنيا في وجه "الزمن الخاسي".
( 9 )
نخلص إلى أن استراتيجية الهدف والمنطلق استولدت استراتيجية المقاطع التي جاءت بِنيَتُها مُحكَمة الترابط لغويا وشعوريا وفكريا. كما استولدت استراتيجية فنية تراوح بين تعبير مباشر يوازي الوظيفة (الدفاعية) للنص، وبين تعبير رمزي متواضع في مواطن استجابت لاستراتيجية الدفاع، وفائق في مواطن أخرى استجابت لاستراتيجية الإبداع، حين أقام الشاعر علاقة جدلية بين تجربته وبين الرمز؛ فأخذ منه، وأضاف إليه إضافة شاعر مقتدر مبتكر.



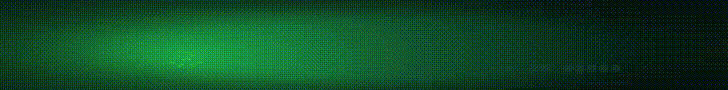

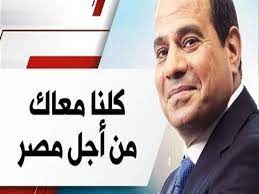
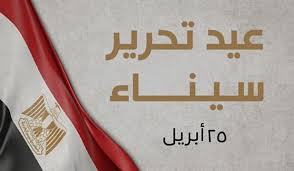












 حكم جديد بالبراءة يرسى قواعد هامه .. نجاحات قانونيه تضاف للمساعد والخبير
حكم جديد بالبراءة يرسى قواعد هامه .. نجاحات قانونيه تضاف للمساعد والخبير تموين كفرالشيخ يشن حملات على الاسواق
تموين كفرالشيخ يشن حملات على الاسواق «مستانف الإسماعيلية » تقضي بإلغاء حكم السجن المشدد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة
«مستانف الإسماعيلية » تقضي بإلغاء حكم السجن المشدد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة خروج الفتيات المصابات باختناق في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية
خروج الفتيات المصابات باختناق في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لقاء الرئيس السيسي والأمير بن سلمان يؤكد قوة الشراكة المصرية السعودية
لقاء الرئيس السيسي والأمير بن سلمان يؤكد قوة الشراكة المصرية السعودية الرئيس السيسي يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
الرئيس السيسي يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 جوائز رئيسية يقدمها مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب
4 جوائز رئيسية يقدمها مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب البطولة الرمضانية: مباراتان فاصلتان اليوم لحسم الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة
البطولة الرمضانية: مباراتان فاصلتان اليوم لحسم الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة