قراءة في ديوان أبواب كثيرة لعدن
د. محمد سعيد شحاتة يكتب٪ تفكيك المعنى وتشظي الوجود في شعر منال رضوان


يمثّل ديوان "أبواب كثيرة لعدن" للشاعرة منال رضوان (دار إضاءات، 2024) تجربة شعرية متفرّدة تنفتح على أفق وجودي وفلسفي متشابك، يستحضر فيه النص الشعري العدم والغياب والموت والحرية، في علاقة متوترة مع الذات واللغة والآخر؛ إذ لا ينحصر الديوان في كونه بنية شعرية جمالية، بل يتجاوز ذلك ليؤسس خطابًا يشتبك مع أسئلة الإنسان الكبرى في لحظة معاصرة مأزومة، حيث يتقاطع الخاص بالعام، والأنثوي بالكوني، والتجربة الذاتية بالذاكرة الجمعية.
يتميز الديوان بقدرة عالية على تفجير اللغة من داخلها، عبر صور شعرية مكثفة وانزياحات أسلوبية متواصلة، تجعل المعنى دومًا في حالة تأجيل وتفلت، وهو ما يقرّب النصوص من أفق القراءة التفكيكية التي ترى في النص بنية مفتوحة غير قابلة للإحاطة النهائية. كما ينفتح الديوان على سرديات داخلية تستبطن الذاكرة الفردية والجمعية، مستثمرة عناصر الحكاية (الشخصية، الفضاء، الزمن) لتوليد شعريّة سردية فريدة تزاوج بين البوح الذاتي والمناخ الملحمي.
من جهة أخرى فإن حضور التناصات الميثولوجية والدينية (بروميثيوس، المسيح، زيوس، جُلجثة) والتاريخية (النكبة، فلسطين) يؤكد أن النص الشعري عند منال رضوان يشتغل في فضاء ثقافي واسع؛ حيث تُستعاد الرموز والوقائع بوصفها علامات متجددة الدلالة، قادرة على أن تُعيد صياغة وعي القارئ بالواقع والمصير، وهذا التعدد في مستويات الاشتغال النصي (اللغوي، السردي، الفلسفي، التناصي) يمنح الديوان ثراءً دلاليًا ومعرفيًا يستدعي مقاربة منهجية مركّبة، وعليه فإن هذه الدراسة تقترح قراءة الديوان من خلال أربعة محاور أساسية:
1. البنية اللغوية والأسلوبية: دراسة الانزياحات والصور الشعرية وآليات إنتاج الدلالة.
2. البنية السردية للشعر: تتبع آليات السرد داخل النص الشعري من حيث الصوت والزمن والفضاء.
3. البعد التفكيكي–الفلسفي: مقاربة ثيمات العدم والغياب وتشظي الذات.
4. التناصات الثقافية والرمزية: قراءة استدعاء الميثولوجيا والدين والتاريخ في بناء رؤية شعرية جديدة.
بهذه المقاربة المركبة، تسعى الدراسة إلى الكشف عن الرؤية الفكرية والفلسفية الكامنة وراء شعر منال رضوان، وإبراز كيف تتأسس قصائد الديوان كبنية نصية مفتوحة، تحتفي بالتعدد والتشظي، وتطرح أسئلة الوجود والعدم بوصفها جوهر التجربة الشعرية المعاصرة.
أولا: الرؤية الفكرية في ديوان أبواب كثيرة لعدن
الرؤية الفكرية لأي عمل أدبي هي الإطار الذي يشكّل المنطلق العميق للنصوص، ويعكس كيفية تعامل الشاعرة مع الوجود واللغة والذات والآخر، وفي ديوان "أبواب كثيرة لعدن" تتبدّى رؤية فكرية شديدة التشظي، تتوزع بين وعي عدمي بالوجود، ووعي نقدي بالثقافة والرموز، ووعي ذاتي مأزوم بالذاكرة والجسد.
الملمح الأول: مركزية ثنائية الحياة/الموت
يحضر الموت لا كفناء نهائي، بل كمدخل لحياة أخرى، أو كحضور موازٍ للحياة، ففي قصيدة أبواب كثيرة لعدن تقول الشاعرة (الموتُ الذي لم تره عيناه، وجهه تشربته مسامات الروح... حياة أخرى يكسوها الخضر) هنا يتضح أن الموت ليس نقيضًا للحياة، بل هو شرط من شروطها، والرؤية الفكرية للشاعرة تعكس منظورًا وجوديًا شبيهًا بهايدغر حيث العدم جزء من الكينونة.
الملمح الثاني: الحرية المؤجَّلة وزيف الشعارات
الحرية في النصوص ليست قيمة مطلقة، بل مفرغة من مضمونها، بل وتتحول إلى رمز موت، تقول الشاعرة (وماذا عن الحرية؟ أليست أضرحةً رخاميةً لمئات الخيول؟) هذا يشي برؤية نقدية؛ فالحرية لا وجود لها في الواقع، بل تُستخدم كقناع للموت. هنا يظهر البعد التفكيكي الذي يقلب معنى المفردة ويعريها.
الملمح الثالث: الذاكرة بوصفها أثرًا هشًا
النصوص تضع الذاكرة في مواجهة الزمن، لكنها لا تقدّمها كخلاص، بل كحضور ملوث بالغياب (كرة من ثلجٍ آنيةٍ تتزلج على ذاكرتي الدخّانية) الذاكرة هنا ليست طمأنينة بل هشاشة، مجرد أثر زائل. وهذا يتماشى مع تصور دريدا عن "الأثر" الذي يظل ناقصًا، حيث الغياب متجذر في كل حضور.
الملمح الرابع: الشعر كوعي عدمي
الشعر لا يظهر كفن جمالي خالص، بل كفعل عبثي، بل كـ “امتهان للعدم". ففي قصيدة تمرد تقول (الشعرُ يا سادتي امتهانُ العدم) الرؤية الفكرية هنا تسحب البساط من تحت التصورات التقليدية عن الشعر (بوصفه خلاصًا أو خلودًا)، وتضعه في قلب العدمية، كفعل يفضح غياب المعنى بدلا من أن يمنحه.
الملمح الخامس: الثقافة والأسطورة كأقنعة ساقطة
التناص مع بروميثيوس، المسيح، زيوس، كارافاجيو، والنكبة يكشف أن الرموز الثقافية الكبرى لم تعد قادرة على إنقاذ الإنسان من أزمته(أريق الدفء على أكتافهم، قُ ساخرةً على تغافل زيوس) الرموز هنا تُستدعى لتُفكك، ولتكشف عجزها. والرؤية الفكرية تؤكد أن المقدس/الميثولوجي لم يعد يمنح المعنى، بل صار جزءًا من العبث.
الملمح السادس: الأنوثة كمساحة جرح وجودي
يحضر الجسد الأنثوي كفضاء هش، مثقل بالذاكرة والخيبة، لكنه أيضًا مساحة مقاومة (لزوجة الطحالب على فخذي امرأة بائسة) هنا الجسد ليس مجالًا للذة فقط، بل مساحة جرح كوني، يختزن الذاكرة والألم.
الرؤية الفكرية في ديوان "أبواب كثيرة لعدن" تقوم إذن على:
1. تفكيك الثنائيات الكبرى (الحياة/الموت، والحرية/القيد، والحضور/الغياب).
2. وعي عدمي يرى الشعر والذاكرة والرموز جميعًا كمجالات هشة ومفككة.
3. نقد ثقافي للرموز الميثولوجية والدينية والتاريخية التي لم تعد تمنح المعنى.
4. وجودية معاصرة حيث الموت والغياب ليسا نهايات، بل حالات ملازمة للوجود.
5. شعرية الأنوثة المجروحة التي تجعل الجسد ذاته ساحة للصراع مع العدم.
بهذه الملامح، يتضح أن ديوان "أبواب كثيرة لعدن" ليس مجرد نصوص شعرية متفرقة، هو بل مشروع شعري–فكري يسعى إلى مساءلة الإنسان في زمن فقدان اليقين، حيث اللغة والذاكرة والثقافة لم تعد تمنح الخلاص، بل تكشف هشاشة الوجود.
الأبعاد التحليلية للديوان: اللغة والأسلوب، السرد، التفكيك، والتناص الثقافي
يستند هذا التحليل إلى رؤية شاملة للنص الأدبي، تتجاوز القراءة السطحية لتستكشف أبعاده المتعددة من خلال مقاربات مختلفة؛ إذ يتقاطع النص بين مستويات لغوية/أسلوبية دقيقة، وبنية سردية متقنة، ورؤية فلسفية/تفكيكية تكشف عن عمق المعنى وثراء الإيحاءات، إضافة إلى شبكة من التناصات والإحالات الثقافية التي تمنح النص ثقلًا دلاليًا وتواصليًا. ويهدف هذا التمهيد إلى توضيح كيف تتكامل هذه الأبعاد لتقديم فهم أعمق للنص، بحيث يصبح القارئ قادرًا على إدراك التداخل بين اللغة والمعنى، وبين السرد والفلسفة، وبين الذات المرجعية للنص والعالم الثقافي الذي يستدعيه.
المحور الأول: البنية اللغوية والأسلوبية
تقوم تجربة منال رضوان الشعرية في "أبواب كثيرة لعدن" على لغة تتسم بالكثافة والانزياح المستمر؛ حيث لا تُستخدم الكلمات في سياقاتها المألوفة، بل يتم دفعها إلى تخوم جديدة تنتج دلالات غير متوقعة. إنّ اللغة هنا ليست مجرد أداة للتعبير، وإنما هي فضاء وجودي يُعاد تشكيله مع كل قصيدة. ومن هذا المنطلق تصبح دراسة البنية اللغوية والأسلوبية ضرورية؛ لفهم كيف تتشكّل الرؤية الفكرية للشاعرة من خلال اللغة ذاتها، وسوف نركّز في هذا المحور على أربع نقاط أساسية:
1. الانزياح اللغوي (إخراج الكلمات من دلالتها المألوفة).
2. التكثيف الشعري والصورة المركّبة.
3. المفارقة اللغوية والتوتر الدلالي.
4. الإيقاع الداخلي (التكرار، التوازي، التقطيع).
1 – الانزياح اللغوي
الانزياح اللغوي هو خروج الكلمة عن معناها المعجمي المباشر؛ لتكتسب معنى جديدًا عبر السياق الشعري، وعند منال رضوان، يتحقق الانزياح بوصفه أداة لتفجير اللغة من الداخل؛ حيث تُستعمل المفردات المألوفة ("الحرية"، "الموت"، "الوقت") في سياقات غير مألوفة، فتُنتج معاني تنقل القارئ من حدود اللغة اليومية إلى تخوم الغرابة الشعرية:
وماذا عن الحرية؟
أليست أضرحةً رخاميةً لمئات الخيول؟
هنا يتحول مفهوم الحرية من قيمة عُليا إلى "أضرحة" موت، ومن رمز للحركة (الخيول) إلى رمزية للاندثار، والانزياح في الربط بين الحرية/الخيول/الأضرحة يُحدث صدمة دلالية تكشف رؤية الشاعرة للحرية كقيمة مستهلكة ماتت تحت ثقل الاستبداد، وفي موضع آخر:
الوقتُ غيرَ فواجعَ صباحيةٍ بلا توثيق
الزمن هنا ليس تسلسلاً خطيًا، بل يتحول إلى "فواجع"، أي لحظات مشحونة بالفقد، والانزياح اللغوي يجعل "الوقت" كيانا مأساويًا، لا مجرد وعاء للأحداث، وقد يتحول النسيان من فعل طبيعي (نسيان الأحداث) إلى مادة ملموسة ("رماد خزفي") ذات أثر لعين. هنا الانزياح يحمّل "النسيان" طاقة مادية وميتافيزيقية معًا، تقول:
النسيانُ رمادٌ خزفيٌّ يتجسدُ لعنةً
وقد يظهر الانزياح في المفارقة: القاتل لا ينشد عادة السكينة، لكنه هنا يفعل، فيكشف عن عبثية العالم وانقلاب معاييره، تقول:
إذ يباغتك كقاتلٍ ماجورٍ ينشد السكينة
ينشد السكينة عقب آخر قرة دم معتّق
وقيمات القمح اللينول
وقد ينزاح الشعر من كونه فنًا جماليًا إلى "امتهان للعدم". وهنا تُقلب وظيفة الشعر ذاتها، ليصير ممارسة وجودية/عدمية بدل أن يكون تعبيرًا عن الجمال أو الخلود، تقول:
الشعرُ يا سادتي! امتهانُ العدم
لقد لاحظنا أن المفردات المألوفة ("الحرية"، "الموت"، "الوقت") تُستعمل في سياقات غير مألوفة، فتُنتج معاني تنقل القارئ من حدود اللغة اليومية إلى تخوم الغرابة الشعرية.
2 – التكثيف الشعري والصورة المركبة
التكثيف يعني الاقتصاد في الكلمات مع شحنها بطاقة إيحائية عالية، وتلجأ الشاعرة إلى بناء صور مركبة تتداخل فيها مستويات حسية وفكرية ورمزية، والصورة هنا ليست وصفًا خارجيًا بل هي بناء دلالي متعدد، تقول:
مضغة حلمٍ متخثر تنسربُ بلا تأويل
هنا صورة مركبة تجمع بين "المضغة" (جسدية/جنينية) و"الحلم" (روحي/ذهني) والتكثيف يجعل الحلم جسدًا يتخثر وينساب، وفي موضع آخر تقول:
ينتصبان عكازين
يحملان كرةٌ من ثلجٍ
أنيةٌ تتزلجُ على ذاكرتي الدخانية
هنا الذاكرة تتحول إلى فضاء مادي يتزلج فوقه الثلج، والتكثيف هنا يخلق صورة حسية/زمانية تحيل إلى برودة الذكرى، وقد يُجسّد الحزنُ كعائق مادي يمكن التعثر به. التكثيف يحوّل الشعور إلى مادة، تقول الشاعرة:
تتعثر خطاي في حزنٍ آخر
.... في نهر جاف
وتقول في موضع آخر:
أكواب قهوةٍ باردة
وزبد كلام رديء يطفو على طاولتي
القهوة تتحول إلى استعارة عن خيبة وجودية، والتكثيف يجعل اليومي نافذة على الفلسفي، وفي موضع آخر تقول:
يتساقطُ كفراغٍ يخفتُ كوميضِ كؤوسٍ فضيةٍ
صورة مركبة تجمع بين الفراغ والوميض والكؤوس، لتخلق مشهدًا انطفائيًا متدرجًا من الامتلاء إلى الفقد.
3 – المفارقة اللغوية والتوتر الدلالي
تقوم المفارقة على الجمع بين متناقضات في صورة واحدة، بما يولّد توترًا دلاليًا يعكس تشظي الوجود، وقد استخدمت الشاعرة المفارقة في إبراز المعاني المرادة بدقة وعمق، تقول:
إذ يباغتك كقاتلٍ ماجورٍ ينشد السكينة
ينشد السكينة عقب آخر قرة دم معتّق
وقيمات القمح اللينول
مفارقة القتل/السكينة تولّد توترًا يعكس عبثية المصير، وفي موضع آخر يكون التوتر بين صلابة الذات وخيانة الحلم، مفارقة وجودية تكشف عبث الانتظار:
لم يهزمني العمرُ
لم يخذلني أحدٌ
أكثر من خذلان الأحلام القديمة
وقد تكون المفارقة في ربط الحرية/الضرائح؛ لتفضح زيف الشعارات، تقول:
الحرية أضرحة رخامية
المفارقة بين النسيان (زوال الماضي) والغد (أمل المستقبل)؛ لتؤكد عبثية كل شيء، وأن لا أمل في الخلاص:
النسيان هو غدٌ معطوب
وقد تأتي المفارقة بين الشعر/العدم؛ لتقلب وظيفة الفن إلى نقيضها، وتؤكد في الوقت نفسه الفكرة التي تتلبسها، وهي العبثية، وفقدان الأمل، وأن لا شيء يمكن أن يحل المعضلة القائمة والمتشابكة
الشعر امتهان العدم
4 – الإيقاع الداخلي
الإيقاع عند منال رضوان لا يقوم على الوزن الخليلي، بل على التكرار، التوازي، والتقطيع، بما يخلق موسيقى داخلية متوترة تتناسب مع محتوى النصوص (أحمرُ أحمرُ أحمر/ مضغة حلمٍ متخثر تنسربُ بلا تأويل) التكرار ثلاثيًا يخلق إيقاعًا بصريًا/صوتيًا يرسّخ العنف الدموي، وتقول (تضحكين ملء دمعك، وتضحكين ... والليل يضحك في وجهي) التكرار هنا يعكس انفجارًا عصابيًا، ضحكًا ممتزجًا بالبكاء، وفي موضع آخر تقول (لم يهزمني العمرُ لم يخذلني أحدٌ) التوازي التركيبي يخلق إيقاعًا جدليًا، كأن المعنى يتناوب بين القوة والخيانة، وتقول (صمت... صمت... شششششش) التقطيع والتمديد الصوتي يحوّل الصمت إلى إيقاع محسوس، وتقول أيضا (كل مساءٍ... كل مساءٍ) التكرار الزمني يرسّخ إيقاع الرتابة اليومية، في انعكاس للاغتراب الوجودي.
يتضح إذن أن البنية اللغوية والأسلوبية في الديوان لا تكتفي بالزخرف اللفظي، بل تبني رؤية وجودية عبر الانزياح، والتكثيف، والمفارقة، والإيقاع الداخلي.
المحور الثاني: البنية السردية للشعر
إن ديوان "أبواب كثيرة لعدن" للشاعرة يتأسس على شعرية تنفتح على البنية السردية؛ حيث لا يقتصر النص على الصور المتناثرة أو الانفعالات الآنية، بل يبني ملامح حبكة داخلية تتحرك فيها الذات الشعرية بين أزمنة متعددة وأمكنة متداخلة، والسرد هنا ليس مجرد تتابع حكائي كما في القصيدة النثرية التقليدية، بل هو تشكيل شعري–سردي يعيد بناء التجربة الإنسانية في صور مشهدية مكثفة. إنّ قراءة البنية السردية في هذا الديوان تتيح لنا الكشف عن:
• كيف يتوزع الصوت الشعري بين البوح الذاتي والرواية شبه الموضوعية.
• كيف ينكسر الزمن الشعري ليصبح متشظيًا أو دائريًا.
• كيف يتشكل الفضاء النصي كبنية متداخلة بين الجسد والذاكرة والمدينة.
• وكيف تنشأ حبكات شعرية داخلية تزاوج بين الحكي والتأمل الفلسفي.
1 – الصوت الشعري
في الشعر السردي، يتخذ الصوت الشعري دور الراوي، لكنه لا يتخلى عن بعده الذاتي؛ فهو يتنقل بين ضمير المتكلم الذي يبوح، وضمير الراوي الذي يصف ويفسر، وعند منال رضوان يتحوّل الصوت إلى شاهد على العالم، فيصف مشاهد متوترة وملتبسة، وهذا الجمع بين "الأنا" و"الراوي" هو ما يمنح القصيدة بعدًا سرديًا يتجاوز التعبير الغنائي، تقول:
إذ يباغتك كقاتلٍ مأجورٍ ينشد السكينة
عقب آخر قطرةٍ من دمٍ معتّقٍ
وقيْماتِ القمحِ اللينولُ
هنا يتخذ الصوت الشعري دور راوٍ يصف حدثًا: قاتل يقتحم اللحظة، ودم يسيل، والسكينة المزعومة. إن ترتيب المشهد في صورة متسلسلة يعطي النص نبرة حكائية، وفي الوقت نفسه تنفلت اللغة من المباشرة عبر الانزياحات ("دم معتّق") التي تضيف بعدًا شعريًا. إنّ هذا المزج بين الحكي الشعري والتأمل يعكس طبيعة الصوت كـ"شاهد–فاعل"، أي أنه يصف ويشارك في الوقت ذاته.
2 – الزمن الشعري
الزمن في الشعر لا يُقاس بالدقائق والساعات، بل يُعاد تشكيله داخل النص، وفي قصائد منال رضوان، الزمن ينكسر ويتشظى، فلا نكاد نجد خطية سردية، بل نعيش انتقالات بين الماضي والحاضر والذاكرة والحلم، وهذا ما يجعل النص أشبه بلوحات زمنية متراكبة تُروى على هيئة مشاهد متجاورة، تقول:
الوقتُ غيرَ فواجعَ صباحيةٍ بلا توثيق
أحمرُ أحمرُ أحمر
مضغةُ حلمٍ متخثرٍ تنسربُ بلا تأويل
لزوجةُ الطحالبِ على فخذيْ امرأةٍ بائسة
تبدأ الجملة بتحديد الزمن: "الوقت". لكنه مباشرة يُعاد تعريفه: ليس ساعات، بل "فواجع". ينتقل الزمن هنا من وظيفته العادية (قياس الحياة) إلى وظيفة مأساوية (إعادة إنتاج الفواجع). بعد ذلك يتشظى الزمن في صور حسية ("مضغة حلم"، "لزوجة الطحالب") تتنقل بين حلم وجسد وذاكرة. وهذا البناء السردي–الشعري يحوّل الزمن إلى مشهد يروى كحدث وجودي، لا مجرد إطار خارجي للقصيدة.
3 – الفضاء النصي
الفضاء في الشعر السردي يتجاوز كونه مكانًا جغرافيًا ليغدو "مساحة تجربة" تتحرك فيها الذات، وعند منال رضوان، يتداخل الفضاء الداخلي (الجسد، الذاكرة) مع الفضاء الخارجي (البيت، البلدة)، لتتكون شبكة معقدة من الأمكنة التي تُروى كشخصيات لها أدوارها في السرد.
إغفاءةٌ
أراني أكشطُ جدرانَ بيتِ أمي كي أعودَ إلى لون طفولتي
وَتدَانِ مغروسانِ في ساعديَّ أمامي
كلعبةٍ من خيال الظل
ينتصبانِ عكازين يحملانِ كرةً من ثلجٍ
آنيةٍ تتزلجُ على ذاكرتي الدخّانية
وبلدةٌ عابسةٌ تحتضنُ الجليد
الجملة تحركنا عبر فضاءات متعددة: بيت الأم (ذاكرة طفولية)، ساعد الجسد (فضاء داخلي)، خيال الظل (فضاء فني/رمزي)، البلدة العابسة (فضاء خارجي/اجتماعي). كل فضاء يُروى بصفته حدثًا في قصة الذات، والفضاء هنا ليس مجرد خلفية، بل هو بنية سردية تتسلسل كالمشاهد السينمائية، وهذا التعدد المكاني يضاعف من شعرية النص ويجعله نصًا سرديًا بامتياز.
4 – السرد الداخلي (الحبكة الشعرية)
الحبكة الشعرية هي الحدث الداخلي الذي يتطور داخل النص، وهي ليست حبكة بالمعنى القصصي الصارم، لكنها بنية تتتابع فيها الأحداث والمشاهد داخل القصيدة، ومنال رضوان تخلق في نصوصها توترًا سرديًا يتصاعد، يبدأ من لحظة بسيطة ثم ينفتح على أفق وجودي أوسع.
اكتب وكأنك على حافة هاوية
الاستشفاءُ بخطايا جديدةٍ
حيلةٌ مارقةٌ في جحيم الطريق
تقليمُ الحرفِ
شدُّ الوعورِ
كتهذيبِ عاهرةٍ فوق فراش مخيلتكَ
تنسكبُ ليلَ نهار
الركضُ بدائرةٍ صمّاء معصوبةٍ
كي تصلَ إلى نقطة اللا نهاية
نرى هنا حبكة متصاعدة: الكتابة ← الهاوية ← الخطايا ← الجحيم ← الركض، وتتنامى الأحداث كما لو كنا نتابع رحلة وجودية في دائرة مغلقة، والجملة الطويلة تحافظ على تسلسل سردي بينما تُغذّيه بالصور الشعرية الكثيفة ("تقليم الحرف كتهذيب عاهرة"). إنها حبكة شعرية داخلية تكشف أن النص لا يكتفي بالبوح، بل يحكي مسارًا مأساويًا وجوديًا.
5 – تداخل السرد مع التأمل الفلسفي
يتقاطع السرد، في كثير من نصوص الديوان، مع الفلسفة؛ فالحكي لا يقف عند وصف مشهد أو حدث، بل يتداخل مع أسئلة وجودية حول الشعر، والعدم، والحرية، والموت. وهذا التداخل يخلق نصوصًا هجينة، تنبني كقصص قصيرة مؤلمة، لكنها مشبعة بالتأملات.
الشعرُ بشدقيَّ اجترارِ الألم
الشعرُ يا سادتي امتهانُ العدم
هو اعترافٌ
طوقُ نجاةٍ
وهو انتحارُ الرمادي
واجتثاثُ القيحِ من أصابعي الملوثةِ بالشعر
كيما أعود ألثم الرسائلَ البتراء
ويدًا زرقاءَ
وأودّعها إلى الجليد.
الجملة تسرد رحلة داخلية تبدأ من وصف الشعر كاجترار للألم، ثم تنعطف إلى حكم فلسفي ("امتهان العدم")، ثم تعود إلى حدث اعترافي (الاجتثاث والعودة)، وتنتهي بمشهد وداعي مأساوي. وهذا التسلسل السردي ليس خطيًا، بل هو دائري، يلتف حول سؤال وجودي: ما معنى الشعر؟ وبذلك يتضح كيف يتشابك السرد مع الفلسفة؛ ليكوّنا معًا مشهدًا شعريًا–فكريًا متكاملاً.
يُظهر تحليل الأمثلة السابقة أن منال رضوان تبني نصوصها على سردية داخلية تتعدد فيها الأصوات، ويتشظى الزمن إلى لحظات متراكبة، ويتداخل الفضاء بين الجسد والمدينة والذاكرة، فيما تتنامى الأحداث داخل حبكات شعرية صغيرة تنفتح على أسئلة فلسفية كبرى، وهكذا يغدو الديوان نصًا سرديًا شعريًا بامتياز؛ حيث يشتبك الحكي مع الشعر ليقدّم رؤية وجودية شاملة.
المحور الثالث: البعد التفكيكي–الفلسفي
يمثّل ديوان "أبواب كثيرة لعدن" نصًّا مفتوحًا على الفلسفة أكثر مما هو منغلق في الغنائية. إنّ الشاعرة تستند إلى ما يمكن تسميته بـتفكير شعري، حيث تتحول اللغة إلى مختبر لتفكيك الثنائيات الكبرى (الحياة/الموت، والحرية/القيد، والحضور/الغياب، والذاكرة/النسيان). هذا ما يجعل مقاربة الديوان من منظور التفكيك الفلسفي ضرورية؛ لأنها تكشف كيف يتسرب معنى النص من بين يدي القارئ، وكيف يظل في حالة تأجيل مستمرة.
كذلك، ينفتح النص على أفق وجودي قلق، يعيدنا إلى أسئلة كامو وسارتر وهايدغر عن العدم والحرية والقلق، والقصائد لا تعطي إجابات، بل تثير أسئلة متجددة، متكئة على صور متناقضة تتجاور في النص نفسه، وكأن الشاعرة تؤكد أن العالم لا يُفهم إلا عبر تشظيه.
1 – تفكيك ثنائية الحرية/الموت
من الثنائيات المركزية في الديوان ثنائية الحرية والموت، وعادة ما تُقدَّم الحرية كقيمة إيجابية، لكن النص يعيد تعريفها عبر صور تربطها بالموت والفناء، وهذه المقاربة تقارب مفهوم دريدا عن "موت المرجع"؛ حيث الكلمة (الحرية) لا تحيل إلى معناها التقليدي بل تنزاح إلى معنى نقيض.
وماذا عن الحرية؟
أليست أضرحةً رخاميةً لمئات الخيول؟
شواهد لقيطة تعلن انتصار جماجم مضمخة بالعشب؟
الضوء المعتم
واللوحة حين تصير واقعًا
ما تأويل وجهي إذا أمسيت مسخًا؟
الحرية تتحول إلى "أضرحة"، والخيول (رمز الانطلاق) تتحول إلى جماجم. هذا الانزياح يعرّي زيف الشعارات التي تحوّلت إلى موت، والتفكيك هنا يقوم على قلب الثنائيات: الحرية لا تُعرّف بالحياة، بل بالموت. والنص يفضح البنية الأيديولوجية التي تجعل الحرية مجرد قبر، والسؤال الوجودي في آخر المقطع ("ما تأويل وجهي...") يربط موت الحرية بمسخ الذات.
2 – تفكيك ثنائية الزمن/الذاكرة
الزمن عند منال رضوان ليس خطيًا، بل يتقاطع مع الذاكرة في علاقة مأزومة، والذاكرة لا تنقذ الزمن من الضياع، بل تكشف عن هشاشته، والذاكرة هي "أثر" ناقص دائمًا؛ لأنها تستدعي الغياب لا الحضور.
إغفاءةٌ
أراني أكشطُ جدرانَ بيتِ أمي كي أعودَ إلى لون طفولتي
وَتِدَانِ مغروسانِ في ساعديَّ أمامي كلعبةٍ من خيال الظل
ينتصبانِ عكازين يحملان كرةً من ثلجٍ
آنيةٍ تتزلجُ على ذاكرتي الدخّانية
وبلدةٌ عابسةٌ تحتضنُ الجليد
الزمن يتشظى هنا بين الماضي (بيت الأم/الطفولة)، والحاضر (الذاكرة الدخانية)، والمستقبل المسدود (بلدة تحتضن الجليد) والنص يفتّت مفهوم الزمن عبر ذاكرة هشّة تتزلج عليها كرة من ثلج، إنها صورة تكثّف هشاشة الوجود، والتفكيك يعمل هنا على إلغاء التراتب بين الماضي والحاضر والمستقبل، كلها تتجاور في آن شعري واحد، لكنها بلا ثبات.
3 – تفكيك ثنائية النسيان/الغياب
يتحوّل النسيان، في نصوص كثيرة، من فعلٍ سلبي إلى بنية وجودية؛ حيث الغياب لا يُفهم بوصفه نقصًا، بل حضورًا من نوع آخر. هذا يعكس فكرة دريدا عن أن "الغياب جزء من الحضور"، وأن كل معنى يحمل أثر ما غاب.
النسيانُ رمادٌ خزفيٌّ يتجسدُ لعنةً
هو غدٌ معطوبٌ
هو رفات بغيٍّ يلفها النهر
النسيان هنا ليس مجرد فقد، بل هو "رماد خزفي"، أي أثر باقٍ لا ينمحي. لكنه أثر لعنة، يترسب في الغد كعطب، والنص يفتّت الثنائية؛ فالنسيان لا يُقابل التذكر، بل يصبح في ذاته ذاكرة مشوهة، والتفكيك هنا يجعل النسيان حضورًا مُظللاً بدلا من أن يكون غيابًا. والفلسفة الوجودية تلتقي مع النص، إذ يُصور النسيان كشرط إنساني لا مهرب منه.
4 – تفكيك ثنائية الشعر/المعنى
من أبرز مظاهر التفكيك في الديوان قلب وظيفة الشعر ذاته، فبدلاً من أن يكون الشعر بحثًا عن المعنى أو احتفاءً بالوجود، يتحوّل إلى ممارسة عدمية، وكأن النص يؤكد أن الشعر ليس أداة للتفسير، بل فضاء لتعميق الغموض.
الشعرُ بشدقيَّ اجترارُ الألم
الشعرُ يا سادتي امتهانُ العدم
هو اعترافٌ
طوقُ نجاةٍ
وهو انتحارُ الرمادي
واجتثاثُ القيح من أصابعي الملوثة بالشعر
كيما أعود ألثم الرسائل البتراء
ويدًا زرقاء
وأودّعها إلى الجليد
النص يفتّت معنى الشعر ذاته؛ فهو اجترار/امتهان/اعتراف/انتحار/اجتثاث. وهذه التعددية تلغي المعنى الواحد للشعر. فالمعنى لا يستقر، بل يتأجل في شبكة من الدوال المتعارضة، وهذا يتوافق مع رؤية دريدا: لا وجود لجوهر ثابت، بل لمعنى دائم الانزلاق. فلسفيًا، والنص يضع الشعر في مواجهة العدم لا كخلاص، بل كفضاء لإعادة إنتاج الأزمة.
5 – تفكيك ثنائية الوجود/العدم
تتصدر ثنائية الوجود/العدم مشهد الديوان، ولكن النص لا يقدمها كضدين واضحين، بل يجعل العدم متسربًا في صميم الوجود، وهنا يحضر أثر هايدغر (الكينونة منفتحة على العدم)، كما يحضر عبث كامو في مواجهة فراغ المعنى.
الموتُ الذي لم تره عيناه
وجهُه تشربته مساماتُ الروح
أيقظه كرضيعٍ يدغدغُ كنوزَ الحليب
حياةٌ أخرى يكسوها الخضر كَرِداءٍ
كان يبغض من يقصرون الفناء على المتصوفة
الموت هنا ليس نهاية، بل بداية حياة أخرى، ولكنه أيضًا مسكون بالطفولة ("كرضيع") وبالخضرة (رمز الحياة) والنص يفتّت الثنائية "الموت/الحياة" ليست نقيضين، بل حضورين متداخلين، والعدم يتسرب في الوجود، والوجود يتجلى في قلب العدم. هذا الخطاب التفكيكي–الوجودي يجعل النص ساحة لعب للمعنى، حيث لا مرجعية ثابتة، بل حركة مستمرة بين الغياب والحضور.
يتضح من خلال التحليل السابق أن الديوان يشتغل على تفكيك الثنائيات الكبرى: الحرية/الموت، والزمن/الذاكرة، والنسيان/الحضور، والشعر/المعنى، والوجود/العدم. ونلاحظ أن النصوص لا تسعى لتقديم إجابات، بل لتقويض الاستقرار الدلالي، وإبراز انفتاح المعنى على التأجيل والتشظي. وبهذا المعنى يتحول الديوان إلى مختبر فلسفي شعري، يقارب الوجود عبر تفكيك اللغة ذاتها، ويجعل القارئ أمام سؤال دائم لا إجابة نهائية له.
المحور الرابع: التناصات الثقافية والرمزية
يُعدّ التناص أحد أهم سمات ديوان "أبواب كثيرة لعدن"؛ إذ تتقاطع نصوص منال رضوان مع فضاءات ميثولوجية ودينية وتاريخية وثقافية متعددة، والتناص هنا ليس مجرد استعارة أسماء أو رموز، بل هو إعادة تشكيل للذاكرة الثقافية؛ لتصبح جزءًا من البنية الشعرية. وفي ضوء منهج جوليا كريستيفا يمكن القول إن النص الشعري هنا هو "فسيفساء من اقتباسات" حيث يتداخل الماضي مع الحاضر، والأسطوري مع الواقعي؛ لتوليد دلالات جديدة.
من جهة أخرى، يشتغل التناص على نحو تفكيكي؛ فهو لا يعيد إنتاج المعنى الجاهز للرموز، بل يقلبها أو يضعها في سياق عبثي أو مأساوي جديد، وهذا ما يجعل الرموز المستحضرة (بروميثيوس، المسيح، زيوس، جُلجثة، النكبة) جزءًا من خطاب شعري معاصر يتحدث عن الفقد والاغتراب والحرية المؤجلة.
1 – التناص مع الميثولوجيا الإغريقية
الميثولوجيا الإغريقية تحضر في الديوان بوصفها مخزنًا رمزيًا يعاد استدعاؤه لتأويل الحاضر، استخدام أسماء مثل بروميثيوس وزيوس يفتح النص على فضاء أسطوري، لكن إعادة توظيف هذه الرموز في سياق معاصر تكشف تفكيكها وتعرية سلطتها الرمزية.
في عقاب الليل يذبل كظلٍ يتساقط كفراغٍ
يخفت كوميض كؤوسٍ فضيةٍ لثمها الصدأ
يلحق خطواته نحو الجليد
يأتزر بصمته كل حين
أختلس النظر إلى سرقاته
عظامي المطهوة في دسم الوقت
التناص مع "بروميثيوس" هنا لا يعيد الأسطورة كما هي (سرقة النار للبشر)، بل يضعها في سياق انطفائي: الليل، والصدأ، والجليد، والعظام المطهوة. فتتحول الأسطورة إلى استعارة عن الفقد والخذلان؛ حيث البطولة تنقلب إلى عجز، والنص يفكك رمز بروميثيوس، فلا يعود بطلًا، بل ظلًّا يذبل.
2 – التناص مع الديانة المسيحية
الرموز المسيحية تحضر بكثافة في الديوان (المسيح، جُلجثة، الفصح). لكن الشاعرة لا تستدعيها بوصفها أيقونات مقدسة، بل بوصفها رموزًا يُعاد تفكيكها في سياق الألم والمعاناة.
صغيرة..
وثمة أحزان
(جُلجثة) مزدحمة طريقي إليك بالكلمات
الألم كنقوش من أحمر قانٍ تئن كتفي
كفك تعتصرني حد الثمالة
ولا خمر لدي
متسربلة بالشوك أشير إليك
وبنصف لعنة أساق إلى جُلجثة
التناص مع "جُلجثة" (مكان صلب المسيح) يربط تجربة الشاعرة بالصلب والفداء، لكن لا من منظور الخلاص، بل من منظور الألم، فالنص يقلب المعنى التقليدي: جُلجثة لم تعد طريقًا إلى القيامة، بل إلى لعنة وأحزان، والتناص المسيحي هنا يُفكّك، فيتحول الرمز إلى شاهد على العدم بدلًا من الخلاص.
3 – التناص مع الأسطورة واللاهوت (زيوس)
زيوس، كبير الآلهة الإغريقية، رمز للسلطة المطلقة. لكن استدعاءه في الديوان يتم بسخرية لاذعة، مما يعكس موقفًا تفكيكيًا من الرموز الكبرى للسلطة والقداسة:
أريق الدفء على أكتافهم
قُ ساخرةً على تغافل زيوس
أعلّ اجتر الصقيع بلا غدٍ
وأدثر صاحب ذلك القلب المهترئ
ذكر زيوس في سياق "التغافل" و"السخرية" يقلب مكانته كإله للعدالة والقدرة، وهنا يظهر زيوس عاجزًا، ومتغافلًا، وفاقدًا للهيبة. والتناص يُفكك السلطة الأسطورية ويحوّلها إلى مادة للتهكم، وبهذا تكتب الشاعرة أسطورتها الخاصة التي لا تقدّس بل تنزع القداسة.
4 – التناص مع التاريخ العربي/الفلسطيني
القضية الفلسطينية تحضر بوصفها جرحًا مفتوحًا، ويتم التناص معها عبر صور "النكبة"، "فلسطين"، "الأطفال"، لكن هذا التناص لا يأتي في إطار خطاب سياسي مباشر، بل في إطار شعري وجودي يربط الجماعي بالذاتي.
فلسطينُ أطفالٌ اختبأوا تحت جلودنا
وعقب دهشة عرجاء
عدنا نرسمهم فراشاتٍ ملونةً
بفرشاةٍ من عروقنا الخشبية
التناص مع "النكبة" يستحضر الذاكرة الفلسطينية، لكن يُعاد تشكيله بصورة وجودية: الأطفال ليسوا خارج الذات، بل "تحت جلودنا"، والاستعارة هنا تفكك الحدود بين الذاتي/الجماعي، وتجعل النكبة جرحًا داخليًا، والفراشات المرسومة بدم العروق تقلب صورة الجمال إلى مأساة، والتناص التاريخي هنا يُعاد إنتاجه كشعرية للغياب.
5 – التناص مع الفن الغربي (كارافاجيو)
يستحضر الديوان، إلى جانب الرموز الميثولوجية والدينية، رموزًا فنية غربية، مثل "كارافاجيو" (الرسام الإيطالي الباروكي)، وهذا التناص الفني يؤكد انفتاح النص على ثقافة كونية، لكنه أيضًا يشتغل على قلب الدلالة:
هل عانى ليتش معاناة السمال الخشنة؟
مغموسة كارافاجيو
فرشاته بالعهر كصلاة
لم يكن متصوفًا كذلك
لذا يطلقون على الفناء حياةً أخرى؟
كارافاجيو، رمز للرسم الديني–الواقعي، يُستدعى هنا في صورة "فرشاته بالعهر كصلاة"، والتناص يقلب صورة الفنان من قديس جمالي إلى مدنّس، ولكن هذا التدنيس ذاته يُساوى بالصلاة، والتناقض يعكس جدلية الفن/الخطيئة، والمقدس/المدنس. والنص يُفكك الرمز الفني، ويعيد إنتاجه كعلامة على عبثية المعنى.
يتضح من خلال التحليل السابق أن التناص في ديوان "أبواب كثيرة لعدن" ليس زخرفة ثقافية، بل بنية جوهرية تُسهم في تشكيل النص؛ فالرموز الميثولوجية والدينية والتاريخية والفنية تُستدعى لتفكيك ذاتها، ولإعادة إنتاج معنى جديد يقوم على التوتر والعبث والغياب. وبهذا المعنى، تتحول القصيدة إلى فضاء حواري مع ثقافات مختلفة، ولكنها لا تتلقى الرموز كما هي، بل تحوّلها إلى علامات جديدة في نسيج شعري معاصر.
يكشف هذا التحليل أن النص الأدبي ليس مجرد تتابع للجمل أو الأحداث، بل هو فضاء متعدد الأبعاد تتفاعل فيه اللغة والأسلوب مع البنية السردية، ويتلاقى فيه التفكيك الفلسفي مع شبكة التناصات الثقافية لتشكيل تجربة قراءة متكاملة؛ فاللغة والأسلوب يوجدان كحامل للتجربة الجمالية والدلالية، والسرد يبني الفضاء والزمن الروائي، في حين يتيح التفكيك التأمل في ثنائية المعنى والغياب، ويكشف التناص عن امتداد النص في الحقول الثقافية المختلفة، ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة، يتضح أن النص ليس كيانًا مغلقًا، بل حوار مستمر بين اللغة والمعنى، وبين الفرد والثقافة، مما يتيح فهمًا أعمق لأبعاده الفكرية والجمالية.
خاتمة
يكشف ديوان "أبواب كثيرة لعدن" للشاعرة منال رضوان عن تجربة شعرية وفكرية متكاملة، تستند إلى وعي حادّ بالوجود واللغة والرموز، وتتأسس على تداخل أربع طبقات متكاملة: اللغوية–الأسلوبية، والسردية، والتفكيكية–الفلسفية، والتناصية–الثقافية.
فعلى المستوى اللغوي–الأسلوبي، تتبدّى اللغة في الديوان كفضاء انزياحي متوتر؛ حيث تنقلب الكلمات على دلالاتها المعجمية لتكتسب طاقة جديدة (الحرية تتحول إلى أضرحة، والنسيان إلى رماد خزفي، والشعر إلى امتهان للعدم). إنّ هذا الانزياح المقرون بالتكثيف الشعري والمفارقة والإيقاع الداخلي يجعل النصوص مفتوحة على دلالات متشظية لا تستقر في معنى واحد.
أما على المستوى السردي، فإن النصوص تُبنى كبنى سردية–شعرية هجينة، تتحرك فيها الأصوات بين البوح الذاتي والرواية الموضوعية، ويتفتّت الزمن بين الماضي والحاضر والذاكرة والحلم، فيما يتشكل الفضاء من طبقات متداخلة (الجسد، البيت، المدينة، الأسطورة). وبذلك يصبح النص الشعري أقرب إلى حكاية داخلية تتنامى من مشهد إلى آخر، ولكنها حكاية مشبعة بالتأمل والقلق الوجودي.
وعلى المستوى التفكيكي–الفلسفي يعمل الديوان على تقويض الثنائيات الكبرى (الحياة/الموت، والحرية/ القيد، والحضور/الغياب، والشعر/المعنى) فالموت لا يظهر كفناء، بل كحضور آخر، والحرية ليست خلاصًا بل أضرحة، والنسيان ليس غيابًا بل هو أثر باقٍ، والشعر ليس معنى بل هو انفتاح على العدم، وبذلك يتحول النص إلى مختبر فلسفي يشتبك مع أسئلة هايدغر ودريدا وسارتر وكامو حيث المعنى مؤجل دائمًا، والوجود مسكون بالعدم.
أما على المستوى التناصي–الثقافي فإن استدعاء الرموز الميثولوجية (بروميثيوس، زيوس)، والدينية (المسيح، جُلجثة)، والتاريخية (النكبة، فلسطين)، والفنية (كارافاجيو) يفتح النص على فضاء ثقافي كوني. غير أنّ هذه الرموز لا تُستعاد في قدسيتها، بل تُفكك وتُعرّى؛ لتكشف عن هشاشتها أمام أسئلة الإنسان المعاصر. فالميثولوجيا تتحول إلى فراغ، والمقدّس إلى لعنة، والتاريخ إلى جرح داخلي، والفن إلى مزيج من العهر والصلاة.
إنّ الرؤية الفكرية التي تخرج من تداخل هذه المستويات تؤكد أن الديوان ليس مجرد مجموعة من القصائد، بل هو مشروع شعري–فلسفي يسعى إلى مساءلة المعنى ذاته، والرؤية تنبني على وعي عدمي يرى في الشعر مساحة لفضح غياب اليقين، وعلى وعي نقدي يعرّي الشعارات والرموز، وعلى وعي وجودي يجعل الموت والغياب جزءًا من الحياة ذاتها، كما أنّ الجسد الأنثوي يحضر كفضاء جرح وجودي، مثقل بالذاكرة والخسارة، ولكنه في الوقت نفسه مساحة مقاومة وتوليد للمعنى المفتوح.
وعليه، يمكن القول إن ديوان "أبواب كثيرة لعدن" يمثل تجربة شعرية معاصرة تعيد تعريف الشعر بوصفه سؤالًا وليس جوابًا، وحوارًا مع اللغة والرموز والوجود، حيث تتكثف الانكسارات الوجودية والقلق الفلسفي في لغة متوترة، وصور متشظية، وتناصات مفككة؛ ليغدو النص في النهاية أبوابًا مفتوحة على عدنٍ رمزية هي الوجود ذاته: وجود معلّق بين الحياة والموت، وبين الحضور والغياب، وبين الأمل والعدم.



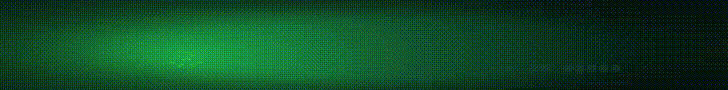




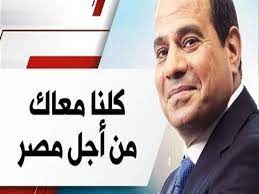
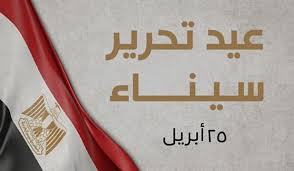












 ضبط مصنع لحوم منتهية الصلاحية بالإسكندرية
ضبط مصنع لحوم منتهية الصلاحية بالإسكندرية استياء شعبي بقرية إدفا بعد وفاة طالب بكلية السياسة والاقتصاد أثناء...
استياء شعبي بقرية إدفا بعد وفاة طالب بكلية السياسة والاقتصاد أثناء... عاجل..سوهاج ..بحصيلة 33 مليون جنيه.. مصرع احد الأشخاص وإصابة 2 آخرين
عاجل..سوهاج ..بحصيلة 33 مليون جنيه.. مصرع احد الأشخاص وإصابة 2 آخرين قنا .. النجار يزلزل الأوكار بالدير الشرقي .
قنا .. النجار يزلزل الأوكار بالدير الشرقي . تكريم الدكتور / محمود ابوعميرة في احتفالية عيد العلم بدبي - الامارات...
تكريم الدكتور / محمود ابوعميرة في احتفالية عيد العلم بدبي - الامارات... 12 جلسة وورشتان علميتان لمناقشة اساسيات علم أعصاب الاطفال بالمؤتمر العلمي السنوي...
12 جلسة وورشتان علميتان لمناقشة اساسيات علم أعصاب الاطفال بالمؤتمر العلمي السنوي... د. محمد سعيد شحاتة يكتب٪ تفكيك المعنى وتشظي الوجود في شعر منال...
د. محمد سعيد شحاتة يكتب٪ تفكيك المعنى وتشظي الوجود في شعر منال...