الأديب سيد غلاب يكتب: بارانويا


هل يوجد أحد ناقص؟
- أنا.
ضحك الركاب، استدركت الأمر بسرعة، ورفعت صوتي:
- لا، لستُ أنا! أنا لست ناقصة.
استمرت الضحكات وتعالت. يا لهم من حمقى!
محاولة معالجة الموقف أردفت:
- أقصد... أخي.
الضحكات تصاعدت أكثر، وكأنني أقدم لهم عرضًا كوميديًا. شددت أصابعي حول حقيبتي، شعرت بأنني محاصرة بنظراتهم.
السائق محاولًا كتمان ضحكته:
- وأين هو أخوكِ هذا؟
- لا أعلم.
- نعم؟!
- أقصد... غفوتُ قليلًا، وحين استيقظت، لم أجده.
- اتصلي به.
تحسست جيب حقيبتي وأخرجت هاتفي المحمول. ضغطتُ على زر الاتصال، فظهر لي الرد الآلي كالصاعقة:
"عفوًا، لقد نفد رصيدكم، برجاء إعادة الشحن وإعادة المحاولة."
شعرتُ بحرارة تتصاعد إلى وجهي. ماذا أقول الآن؟ الباص كله ينتظر ردي. ازداد الطين بلّة، رحلة منحوسة منذ بدايتها!
أخبرته عشرات المرات أنني لا أشعر بالراحة تجاه هذه الرحلة. قلبي كان مقبوضًا، عيني كانت ترفّ، لكن محمود ضحك وقال إنها أوهام. سامحك الله يا محمود! شباب الصعيد يهربون إلى القاهرة كي يتزوجوا فتيات قاهريات، وأنتَ تتركها لتعود إلى الصعيد بحثًا عن زوجة؟ ما هذا الجنون؟
السائق بنفاد صبر:
- يا مدام، نريد أن نتحرك. هل ردّ عليك؟
لم أجد ما أقوله، فتمتمتُ بخفوت:
- رصيدي نفد.
ساد الصمت. وعلى عكس المتوقع، لم أسمع أي ضحكات. تطوع شاب وأخرج هاتفه:
- أعطِني الرقم، يا مدام.
تلعثمتُ وأنا أملي عليه الأرقام. ما إن ضغط الشاب زر الاتصال، حتى انفجرت الأغنية من حقيبتي:
"قلبي عليك خي... من حر قولة آي!"
تسمرتُ في مكاني. يا إلهي... معقول هذا. ارتفع همس الركاب، تداخلت الضحكات وامتزجت بالدهشة، الهواء في الباص أصبح أثقل.
الشاب المتطوع بسخرية وهو يقترب مني، متتبعًا الصوت:
- الصوت قادم من حقيبتك، يا مدام.
قهقه أحدهم:
- سيبك منها، شكلها مصتبحة!
لكن السائق لم يجد الأمر مضحكًا. صاح بحزم:
- أنا ناقص اشتغالات؟ سأغلق الباب ونكمل الطريق.
لم أشعر بنفسي إلا وأنا أصرخ، وأبكي، وأتوّسل إليه:
- لا! محمود كان هنا! كان يجلس بجواري! أنا لم أكن وحدي، أقسم لكم.... فتحت شباك النافذة وصحت: محمود، يا محمود... أين أنت..
رقّ الركاب لحالي وأجلسوني. تجمعت النساء حولي، واحدة أعطتني منديلاً، وأخرى زجاجة مياه. سمعت تمتمات متعاطفة:
يا عيني... ، يا حرام.... الرجال يضربون كفًا بكف. حتى السائق نفسه بدا مترددًا، ثم سأل برفق:
- طيب، يا جماعة... هل رأى أحد محمود هذا طوال الطريق؟
نظرات مترددة. ران الصمت عليهم. لا أحد يتكلم.
أعاد السائق السؤال بصيغة أخرى:
- يا جماعة، منذ أن غادرنا القاهرة قبل خمس ساعات، هل لاحظ أحدكم أن هذه السيدة كانت تجلس بجوار شخص آخر؟ أم كانت وحدها؟
تبادل الركاب النظرات. التوتر واضح في وجوههم. حاولتُ أن أستعطفهم بنظراتي، أحفز ذاكرتهم، حتى نطق أحدهم أخيرًا:
- بصراحة، الركاب طوال الطريق بين نائم، ودافن عينيه في شاشة الموبايل، ومشاهد للتلفزيون.
تابع آخر، بنبرة واثقة:
- لا، لقد كانت تجلس بمفردها. أنا متأكد. كانت وحدها طوال الرحلة.
تجمدتُ في مكاني. هل أنا... وحدي؟ لا، هذا غير ممكن!
لقد كنتُ أشعر بحرارة جسده بجانبي، كنتُ أسمع صوته!
أدار السائق المحرك. بدأ الباص بالتحرك.
تسارعت أنفاسي، التصقت بزاوية النافذة، حدّقتُ في الخارج، بحثًا عنه. بدأ قلبي يخفق بقوة، كأن شيئًا عظيمًا على وشك الانهيار داخلي... فقاعة احتوتني وصرت في دنيا غير الدنيا:
"محمود يا أخي ... يا أبي يا ابني ... كيف تفعل بي هذا، بي أنا... لقد وهبت حياتي لك، البنات أترابي تزوجن وظللت أنا مثل الأرض البور... الأراضي بجوارها ترتوي وتزهر وأنا لا رواء ولا ثمار.... صرت مثالا للعنوسة رغم جمالي...، كم اشتقت إلى لمسة رجل... إلى حضن يظلني يحتويني... سرت في صحراء الظمأ يا محمود حتى جفت منابع الأنوثة داخلي بعد أن وصلتْ إلى قمة الفوران، قمعت تمردها الطاغي ... قتلت الإحساس وأغلقت قلبي عليك وحدك لا أرى ... لا أسمع سوى وصية أبي وأمي.... أين ذهبت يا محمود؟ هل أنا مجنونة وهم؟! هل رحلت بعد أبيك وأمك ومازلت أكابر محاولة النسيان...بدأت أشك في نفسي... أرجوك، ردّ عليّ."
فجأة... شعرتُ ببرودة على وجهي، كأن المطر يتساقط عليّ وحدي. يد باردة تضرب برفق على خدي، وصوت مألوف يهمس برفق:
- تهاني... أنا جنبكِ يا حبيبتي... أفيقي
والركاب بعضهم يبكي، والبعض الآخر يضحك.
والراكب الذي أكد سابقا أنني كنت وحدي، رفع صوته بحسم متباهيا:
- ألم أقل لكم؟ لم تكن وحدها.
أدار السائق المحرك، وانطلق الباص في طريقه.



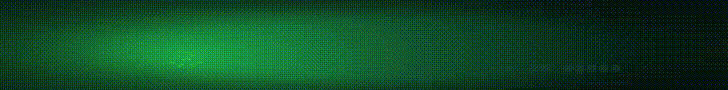













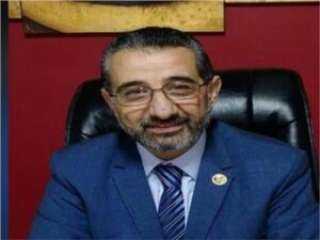

 حريق هائل يدمر مصنع للزجاج بشبرالخيمة
حريق هائل يدمر مصنع للزجاج بشبرالخيمة تحرك كوبري مشاة بطوخ إثر اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة
تحرك كوبري مشاة بطوخ إثر اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة كارثة جديدة على ”الإقليمي” قرب بني سلامة.. مصرع وإصابة العشرات في تصادم...
كارثة جديدة على ”الإقليمي” قرب بني سلامة.. مصرع وإصابة العشرات في تصادم... جريمة هزت المنوفية أب يعذب نجله صعقا بالكهرباء حتي الموت ...
جريمة هزت المنوفية أب يعذب نجله صعقا بالكهرباء حتي الموت ... عادل منير الاتحاد الحالي حقق انجازات كبيرة.... واستهدف ترسيخ مبدأ تداول...
عادل منير الاتحاد الحالي حقق انجازات كبيرة.... واستهدف ترسيخ مبدأ تداول... محافظ المنوفية يتفقد 2 طن لحوم لتوزيعها ضمن صكوك الأضاحي على الأسر...
محافظ المنوفية يتفقد 2 طن لحوم لتوزيعها ضمن صكوك الأضاحي على الأسر... بالصور| افتتاح مميز للبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026
بالصور| افتتاح مميز للبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026 فري فاير تطلق الفصل الثاني من تعاونها مع سلسلة الأنمي NARUTO SHIPPUDEN...
فري فاير تطلق الفصل الثاني من تعاونها مع سلسلة الأنمي NARUTO SHIPPUDEN...