د. داليا عصام أبوالفتوح: الصراع حول معايير تقاسم المياه وقضية بيعها فى حوض نهر النيل


تأتى مسألة تقاسم المياه وإعادة تقييم المعايير التى يتم على أساسها توزيع المياه بين دول حوض النيل بصفتها المجال الثانى من مجالات الصراع المائى فى دول حوض النيل بعد مسألة الصراع حول مدى مشروعية الاتفاقات التاريخية فى حوض النهر التى تناولها المقال السابق بالتحليل. حيث إنه لا يوجد فى النظام الإقليمى لحوض نهر النيل إتفاقية عامة تحدد بشكل عام الأنصبة المائيه بين دول الحوض، اللهم إلا ما كان من إتفاقية عام 1929 التى تم تعديلها من خلال إتفاقية 1959 فى شأن توزيع الحصة التى تعد حق تاريخى مكتسب بين مصر والسودان فقط، كما لا توجد إتفاقية عامة تحدد كيفية تقاسم المياة فى الأحواض الدولية المشتركة عمومًا وحوض نهر النيل على وجه الخصوص.
وقد ظلت مسألة تقاسم المياه وإعادة تقييم معايير توزيع المياه من المسائل الصراعية العالقة بين دول النظام الإقليمى لحوض النيل، إذ تطالب بعض دول المنابع بإعادة تقاسم المياه وكذلك إعادة توزيع الانصبه المائية بين دول الحوض من خلال معايير معينه تستبعد إستئثار مصر والسودان بتلك الحصة التى يحصلا عليها من إيراد النهر، فى حين تواجه مصر والسودان تلك المطالب بطرح معايير أخرى أولى بالإتباع عند تقسيم مياه النهر، وبين هذا وذاك ترتفع أصوات أخرى فى بعض دول المنابع تطالب بإعتبار المياه سلعة إقتصادية تباع وتشترى، وتطالب بالحصول من مصر والسودان على مقابل مادى لحصتيهما، وهو الأمر الذى ترفضه كلتا الدولتين.
فأما الصراع حول معايير تقاسم المياه فى حوض نهر النيل، فقد كان من شأنه أن يطرح العديد من الإشكاليات التى تتراوح بين تمسك بعض الدول بالحق التاريخى المكتسب لها فى المياه، وتمسك بعض الدول الأخرى بالحق فى التحكم فى مياه النهر بإعتبارها الأكثر اسهاماً فى إيراده المائى، وتسمك فريق آخر من الدول بالتساوى فى حصص مياه النهر، ومطالبة طائفه أخرى من الدول بإخضاع مسألة تقسيم المياه لمعيار حاجة كل طرف. غير أن حقيقة الموقف إنه لا توجد قواعد قانونية محددة تتناول بالتحديد على وجه اليقين كيفية توزيع مياه الحوض النهرى الدولى الذى تتشاركة مجموعة من الدول. وإن لم يحُل ذلك دون تعدد المحاولات الدولية والاجتهادات البحثية فى هذا الصدد.
حيث إتجه مجمع القانون الدولى عام 1961 نحو إقرار عدد من المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق وواجبات الدول المنتفعة من الأنهار الدولية، وبخاصة وضع ضوابط مبدأ الاقتسام المنصف، فكانت أبرز هذه الضوابط هى وجوب التعاون والتشاور بشأن المشروعات المقترحة، ووجوب سداد التعويضات المناسبة الناتجة عن الضرر الذى يتسبب فيه سوء إستغلال النهر من قبل أحد اطراف الحوض النهرى، ووجوب تسوية المنازعات بين الدول المنتفعه بالطرق السلمية إذعانًا لمبدأ حسن الجوار، ناهيك عن عدالة توزيع مياه النهر، ووجوب التعاون فى استغلال مياهه. وهى المبادئ التى أسهمت فى إستقرار عرف دولى بشأن قاعدة الإقتسام المنصف لفوائد النظام المائى المشتركة. وقد كشفت الممارسه الدولية أن الانصاف فى هذا الصدد يرمى إلى الموازنه بين الإحتياجات الفعلية ووسائل إشباعها على أساس أهميتها النسبية فى مواجهة بعضها البعض فى ظل الظروف السائدة فى كل من الدول النهرية المشتركة.
كما كان من شأن قواعد هلسنكى لعام 1966 أن جاءت بمجموعة من الضوابط حول السبل القانونية لإستغلال وادارة الأنهار الدولية وحل المنازعات بين الدول أطراف النظام الاقليمى للحوض النهرى الدولى فى حالة غياب الاتفاقيات المنظمة لذلك وعدم وجود عرف إقليمى بين هذه الدول فى تلك الشؤون. ومن أهم الضوابط التى تتضمنها قواعد هلسنكى، احترام الحقوق التاريخية المكتسبة، وامتناع الدول المنتفعه عن تحويل مجرى النهر أو انشاء سدود أو خزانات عليه يمكن أن تؤثر على حصص الدول الأخرى دون تشاور مسبق، وعدالة توزيع المياه بين دول الحوض، ووجود آلية سلمية لتسوية المنازعات بين دول الحوض، ووجوب سداد التعويضات الناشئة عن سوء إستغلال أحد دول الحوض النهرى. كما انضوت قواعد هلسنكى على مبدأين أساسيين لتقاسم المياه هما المعقولية والعدالة، كما أشتملت المادة الخامسة على أحد عشر عاملًا ومؤشرًا إرشاديًا لتحديد مفهومى المعقولية والعدالة للإنتفاع بمياه النهر الدولى أهمها، مدى إعتماد كل دوله من دول الحوض على مياهه، والتكلفة المقارنه بالوسائل البديلة، ومدى توافر المصادر المائية الأخرى، ومدى اشباع حاجات الدولة دون احداث اضرار جوهرى لدول أخرى فى حوض النهر. كما تفرق قواعد هلسنكى بين الأراضى الواقعة داخل حوض تصرف النهر الدولى وبين الأراضى الخارجة عنه، فتعطى للأولى أولوية الانتفاع بمياه النهر. ولا تمنع قواعد هلسنكى الدول المنتفعة بمياه النهر الدولى من تحويل جزء من المياه المخصصة لها لرى أراضيها الخارجة عن حوض تصرف النهر الدولى.
وأنشأت لجنة القانون الدولى ضمن منظومة الأمم المتحدة الهيئة العامة لدراسة مواد القانون الخاص بالدراسات المائية عام 1970، وأكدت الهيئة على مبدأى الأقتسام العادل للموارد المائية، ومسئولية الدولة عن الخسائر المادية التى تلحقها بالدول الأخرى أطراف الحوض النهرى.
كما جاءت القواعد التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 1977 بشأن تقاسم المياة متوافقه مع قواعد هلسنكى، حيث نص بيان المؤتمر على أنه فى حالة عدم وجود اتفاق حول طريقة الانتفاع بالموارد المائية فإنه ينبغى على الدول المشاطئة للنهر الدولى تبادل المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها لإدارة مياه النهر بحيث يمكن تجنب إلحاق الضرر بالدول المشاركة بمياه النهر. فضلًا عن إعتماد عدد من المعايير لتقسيم موارد مياه النهر أهمها، مساحة الحوض المغذى للنهر، ومناخه، ونوعية استخدامات المياه، وحاجة كل دولة للمياه، وعدد سكان الحوض النهرى، ودرجة إعتمادهم على مياه الحوض النهرى، والتعويض المادى للأطراف المتضررة.
وجاءت بعد ذلك الاتفاقيه الاطارية للأمم المتحدة للإستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية مستندة على فكرة الوحدة الطبيعية من الناحية البيئية والجغرافية والهيدروجغرافية للنهر الدولى، ومقصيه مبدأ هارمون الذى كان يقوم على السيادة المطلقة للدولة على جزء النهر المار بإقليمها. كما أبرزت اتفاقية الأمم المتحدة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول من خلال نص المادة الخامسة من متنها. ويقوم مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول على أساس أن لكل دوله نهرية الحق فوق إقليمها فى نصيب معقول ومنصف من استخدام مياه النهر، وهو الحق الذى يقيد بمبدأ المعقوليه والإنصاف وعدم الإضرار بحقوق ومصالح الدول الاخرى الأطراف فى حوض النهر. ويترتب على الاشتراك المنصف والمعقول أنه يتعين على كل دوله أن تتعاون وتشارك على قدم المساواه فى حماية وتنمية هذا المجرى، مثل القيام بإجراءات الحفظ والأمن، ومكافحة الأمراض، وغير ذلك. ويستند هذا المبدأ إلى المساواه فى السيادة بين الدول النهرية، وهو ما يشير إلى مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة التى تطرقنا إليها فى المقالات السابقه، وهو ما يعنى أن للدوله الحق السيادى فى استخدام المياه داخل اقليمها شريطة عدم الحاق الضرر بالدول الأخرى.
وفى شأن المعايير التى يستند إليها مبدأ الإستخدام المنصف والمعقول الذى جاءت به المادة الخامسة من إتفاقية الأمم المتحدة، فقد جاءت المادة السادسة من ذات الاتفاقية لتتضمن الاشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى العوامل التى يؤخذ بها عند تقدير الاستخدام المنصف والمعقول للنهر الدولى، فأفردت فيها العوامل الجغرافية والمناخية وغيرها من العوامل الأخرى، والحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول النهر الدولى، والسكان الذين يعتمدون على النهر، وآثار استخدام النهر فى أحد الدول على بقية الدول الأخرى المشاطئة للنهر، والاستخدامات القائمة والمحتملة للنهر، ومدى توافر البدائل؛ على أن يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من تلك العوامل وفقًا لأهميته مقارنة بأهمية العوامل ذات الصله. وهى العوامل التى تتشابه إلى حدٍ كبير بما جاءت به قواعد هلسنكى. وقد تقدمت إثيوبيا أمام مجموعة العمل حين العمل على الاتفاق الاطارى للأمم المتحدة بإقتراح النظر إلى عامل مدى مساهمة كل دوله من دول النهر فى ايراده، فى حين أقترحت مصر أن يؤخذ بعين الإعتبار عامل إمكانية وجود مصادر مائيه أخرى.
وقد كان من مسألة عدم التوافق فى القانون الدولى على قواعد ومعايير محددة فى شأن تقاسم مياه الأنهار الدولية أن دفعت بالباحثين نحو الاجتهاد فى هذا الصدد، الذى اسفر عن التوصل إلى معيارين رئيسيين لتقسيم مياه الانهار الدولية هما التوزيع بحسب الحاجة، والعدالة الاقتصادية. حيث تتبنى دول المنابع مواقف متشدده إتكاًء على الأسس الجغرافية التى تعتمد على تحديد منبع النهر والمساحة التى يشغلها فى الدوله ذات العلاقة، وهو الموقف الذى واجه دول المصب ولم يؤدى سوى إلى تصاعد الموقف بين الدول اطراف النهر الدولى، فى حين أن العديد من أزمات المياه قد حُلت من خلال الاستناد إلى مبدأ التوزيع بحسب الحاجه على غرار ما كان من اتفاقية مصر والسودان لعام 1929 التى تم تعديلها عام 1959 والتى تم توزيع المياه فيها بحسب حاجة كل من الدولتين فحصلت مصر على حصة 55.5 مليار متر مكعب وحصلت السودان على 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. كما كان من مفاوضات تقاسم المياه بين الأردن وفلسطين وإسرائيل ان أعتمدت ذات المعيار – معيار التوزيع بحسب الحاجه -، غير أن الدول أطراف النظام الإقليمى لحوض النيل ترفض الأخذ بهذا المعيار، حيث تعترض على إتفاقية 1959 لتوزيع المياه بين مصر والسودان، رغم أن تلك الإتفاقية لا تقوم بتقسيم إيراد النهر فحسب بل تقوم بتوزيع الحق التاريخى المكتسب، والموزع بحسب الحاجه والاستخدام بين مصر والسودان. فى حين توصلت الدراسات الحديثه فى أغلبها إلى أن الاعتماد على الجوانب الاقتصادية فقط لا يمكن أن يضمن حلولًا مقبولة لمشاكل توزيع المياه، وبخاصة بين الدول المتنازعة.
وعلى الرغم من كل تلك الجهود الدولية لإرساء معايير تقسيم مياه الأنهار الدولية على نحو عادل ومنصف، فقد اعربت دول حوض النيل بكافة السبل الممكنه عن رفضها لمعايير تقسيم مياه النيل، وهو الرفض الذى يرجع بجذورة إلى أول إتفاق لتقسيم مياه النيل بين مصر والسودان عام 1929 والذى نص بموجبه على حصة 48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليار متر مكعب للسودان سنويًا. وقد كان الخلاف حينها بين مصر من جانب وباقى دول حوض النيل من جانب ثانى، وبخاصة السودان التى رأت فى مثل هذا الاتفاق اجحاف بحقها حيث لا تزيد حصتها عن 1: 12 من حصة مصر من جانب وتقيد الاتفاقية حق السودان فى إستخدام مياه النيل فى مواسم معينه.
أما عن باقى دول حوض النيل فترفض الاعتراف بالاتفاقية الأولى لتقسيم مياه النيل بين مصر والسودان لعام 1929، والاتفاقية الثانية للإنتفاع الكامل بمياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959، وفى المقابل تتمسك دول حوض النيل بمعيارين اساسيين لتقسيم المياه هما مساحة التصريف فى كل دوله من دول الحوض، ومساهمة كل دولة فى الايراد المائى للنهر، متذرعة بما جاءت به قواعد هلسنكى فى المادة الخامسة من معايير توزيع المياه بشكل عادل ومنصف، حيث نصت فى جملة ما أوردته على مساحة الحوض النهرى الذى يمر عبر الدولة، ومدى مساهمة الدول النهرية فى الايراد المائى للنهر.
وهما المعيارين اللذان لا يصلحا للإرتكاز عليهما فحسب وفقًا للمنطق العلمى والعملى لعملية تقاسم المياه. إذ لو أُخذ بالمعيار الأول الخاص بمساحة حوض النهر الذى يمر عبر الدولة لأتضح أن السودان تحتل القسم الأكبر من مساحة حوض النيل بنسبه قدرها 63.6%، يليها إثيوبيا بنسبة 11.7% ثم مصر بنسبة 10.5%، يليها باقى دول حوض النيل وهو المعيار الذى يعطى الأفضلية للسودان أولًا ثم إثيوبيا ثم مصر، ثم باقى دول حوض النيل. أما لو أخذ بالمعيار الثانى الخاص بدرجة المساهمة المائيه لوجد أن إثيوبيا تساهم بالنصيب الأكبر يليها كينيا ثم تنزانيا، ولا تساهم السودان سوى بـ 1% من إجمالى تصريف الحوض، فى حين لا يوجد أى مساهمة لمصر فى إجمالى تصريف الحوض السنوى، وبالتالى ووفقًا لهذا المعيار فإن الأفضلية تكون لإثيوبيا يليها كينيا ثم تنزانيا، ثم باقى دول حوض النيل، وتأتى الحصة المصرية فى المركز الأخير.
أما عن موقف مصر والسودان من تلك المعايير فقد قامت كلتا الدولتين عقب إبرامهما لإتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النهر لعام 1959 بإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياة النيل بين مصر والسودان، وقد دخلت تلك الهيئة مباشرة عقب إنشائها فى محادثات فنية غير رسمية مع دول شرق إفريقيا لبحث مطالبها فى مياه النيل، حيث احتجت تلك الدول على توزيع حصص المياه بين مصر والسودان الذى تم بموجب اتفاقية 1959، وبدأت المحادثات بين الهيئة من جانب وأوغندا وكينيا وتنزانيا من جانب ثانِ فى اكتوبر 1961 لتبادل الآراء حول مطالب هذه الدول من مياه النيل. كما أن اتفاق عام 1959 قد تضمن من خلال نص المادة الثانية من متنه؛ الاتفاق على أن تبحث مطالب دول الحوض الأخرى من مياه النيل وتتفق الدولتان المتعاقدتان على رأى موحد بشأن هذه المطالب، وإذا توصلت الدولتان المتعقدتان على قبول تخصيص أى كمية من مياه النهر لأى من دول الحوض الأخرى فإن هذا القدر يخصم مناصفةً بينهما عند أسوان. وأستمرت المحادثات بين الهيئة ودول حوض النيل إلى أن توصلت إلى إقرار قيام مشروع الدراسات الهيدروميرولوجية بحوض البحيرات الاستوائية الذى إبتدأ منذ عام 1967.
ويتكئ الموقف المصرى والسودانى فى شأن تقاسم مياه الأنهار الدولية عمومًا وتقاسم مياه نهر النيل على نحوٍ خاص على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر الدولى، على أن يكون التقسيم العادل والمنصف لمياه النهر بعد مراعاة الحقوق التاريخية المكتسبة التى كانت تحصل عليها كل الدول فى الماضى، إذ إن من شأن المساس بهذه الحقوق تعريض استقرار العلاقات الدولية بين دول الحوض النهرى وكذا السلم والأمن الدولى للخطر. وذلك مع الأخذ فى الاعتبار جميع العوامل الأخرى ذات الصلة. ويُعلى الجانب المصرى من شأن بعض المعايير التى يعول عليها لتقسيم المياه بشكل عادل ومنصف، وعلى رأسها معيار توزيع المياه بحسب الحاجة – حيث إن درجة إعتماد مصر على مياه النيل تفوق درجة إعتماد أي دولة نيليه أخرى – يليه درجة إعتماد السكان على مياه النهر، والاستخدامات الماضية التاريخية والقائمة والمحتملة للنهر، ومدى توافر المصادر المائية الأخرى. كما يؤكد الموقف المصرى على أن هناك إتفاقًا عامًا على بعض القواعد الأساسية التى يتعين لها أن تسرى على دول حوض أى نهر دولى فى شأن حقوقها وواجباتها ومنها، توزيع واستخدام مياه النهر توزيعًا عادلًا ومنصفًا، واحترام الحقوق المكتسبة للدول المنتفعه بالنهر على أساس حاجة كلٍ منها ومدى إعتمادها على موارد النهر، وضرورة تشاور دول الحوض النهرى مع بعضها البعض قبل قيامها بتحويل مجرى النهر، والتعويض المناسب فى حالة حدوث أى خسائر.
كما أعربت مصر عن رؤيتها فى شأن مسألة تقاسم مياه الأنهار الدولية إبان التصويت على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية. فأكدت على أملها فى أن تسهم الإتفاقيه الجديدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن تأكيدها أن الإتفاقية الجديدة يجب ألا تنال من القواعد العرفية الدولية المستقرة فى مجال تقاسم مياه الأنهار الدولية واستخداماتها فى غير الأغراض الملاحية، فضلًا عن حرص مصر على التنويه على أن معايير التقاسم المنصف للمياه لا يمكن لها بحال من الأحوال أن تنسخ أية معايير أخرى سبق وأن استقرت فى العرف الدولى، أو أن تكون بديلًا عنها، كما أكدت على ضرورة الربط بين هذا المبدأ ومبدأ عدم الإضرار الجوهرى. وعلى ذلك يتضح توسد الموقف المصرى والسودانى إزاء مسألة تقاسم المياه فى حوض النيل على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر.
أما عن مسألة بيع المياه فى حوض نهر النيل، فقد شغلت هذه القضيه حيزًا لا بأس به فى الاطار العام لجملة التفاعلات الصراعية فى حوض النيل، وبخاصة فيما يمس بمسألة تقاسم المياه.
وجدير بالذكر أن مسألة نقل المياه بين الدول كانت قد طُرحت منذ القدم، حيث يعد تزويد العراق للكويت بالمياه – مشروع نقل مياه شط العرب إلى الكويت – من أقدم مشروعات نقل المياه فى المنطقة، ويعود إلى بدايات القرن العشرين عام 1909، وقد توسعت العملية حد إنشاء شركة وطنية لنقل وتوزيع المياه عام 1939، ثم تطورت الفكرة إلى مشروع مد أنابيب بين الدولتين عام 1953، وهو المشروع الذى لم يتم حينها وإن عاود الظهور مرارًا إلا أنه لم يرقى إلى أكثر من كونه طموحًا للتعاون بين الدولتين. وطرح مشروع مماثل لمد قطر بالمياه العذبه من خلال أربعة خطوط أنابيب من إيران، وقد ظل هذا المشروع قيد الدراسه لسنوات حتى اطاحت به حرب الخليج الثانية. وتكررت ذات الفكرة عند طرح مشروع نقل المياه من لبنان إلى الخليج، ومشروع نقل المياه من العراق إلى الأردن، ومشروع نقل المياه من لبنان إلى الأردن، ومشروع أنابيب السلام التركى الذى طرحته تركيا على سوريا والأردن ودول الخليج، وهو المشروع الأكثر إثارة للجدل، وظهرت المشروعات التى تقترح نقل المياه من تركيا إلى إسرائيل؛ وقد أسهمت تلك المشاريع كافة فى ظهور فكرة بيع المياه وتوريدها الدولى، حيث نقل المياه بين الدول فى مقابل مادى يتم تحديده بين الدول أطراف المشروع لكل متر مكعب من المياه. وراجت فكرة بيع المياه وتوريدها مؤخرًا فى منطقة الشرق الأوسط بسبب محدودية الموارد المائيه، فأعلنت المملكة العربية السعودية عن إستعدادها لشراء المياه من أى دوله لديها فائض، وأعربت ليبيا عن إستعدادها لشراء جزء من حصة مصر المقرره بموجب إتفاقية 1959، وأعلنت إسرائيل عن استعدادها لإبرام صفقات سياسية – مائية تضمن لها حصه ثابته فى المياه فى مقابل مادى، أو مقابل تنازلات سياسية مقدمه لدول الصراع العربى الإسرائيلى.
وتعود فكرة بيع المياه إلى إعتبارها سلعة اقتصادية، وهو التوجه الذى أيدته توصيات البيان الختامى الذى أصدره المؤتمر الدولى للمياه والبيئة فى مدينة دبلن بأيرلاندا عام 1992، وهو الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية "قمة الأرض" الذى عقد فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، وأكد المؤتمر على مبادئ دبلن بما فيها مبدأ إعتبار المياه سلعة إقتصادية. ويرى مؤيدوا هذا التوجه أن إدارة المياه كسلعة اقتصادية يؤدى للتوصل إلى استخدام كفء ومتساوى للمياه يرمى إلى حفظ مواردها وحمايتها.
وانطلقت العديد من الدراسات فى شأن بيع المياه والاتجار الدولى فيها، حتى إن إحدى هذه الدراسات ترى فى تطبيق قواعد حرية التجاره فى المياه إمكانية حل الصراعات المائية فى النظم الإقليمية التى تطبق فيها. وقد قامت تلك الدراسه متخذه من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النموذج التى تطبق عليه، فدعت إلى تخصص كل دوله فى انتاج السلع التى تتوافر لديها ميزه نسبيه فيها، فتقوم الدول التى لديها ميزه نسبيه فى وفرة المياه بالتخصص فى انتاج السلع والمحاصيل الزراعية التى تستهلك قدر كثيف من المياه – وهو ما يسمى الاتجار فى المياه الإفتراضية – ومن ثم تقوم بتصديرها إلى دول الندره المائية التى يجب ان تقوم بإنتاج سلع اخرى تتوافر لديها فيها ميزه نسبيه بخلاف السلع القائمه على استهلاك المياه. وقد افترضت هذه الدراسه أن فى ذلك ضمان لكفاءه إستخدام المياه النادرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحل الصراعات المائية فى المنطقة.
ويشهد النظام الإقليمى لحوض النيل تعارضًا فى الرؤى والتوجهات وتجاذبًا تاره وتنافرًا تاره أخرى بين دول المنبع ودول المصب فى شأن قضية بيع المياه. حيث لا تقتصر مطالبات دول المنبع على مسألة إعادة تقسيم مياه النيل ومراجعة توزيع الانصبه ورفض الاعتراف بإتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959 – التى تقوم بتقسيم الايراد الناتج عن التدفق الطبيعى للنهر – فحسب، بل تنحسر ارادة بعض تلك الدول لتكشف عن المطالبات بتسعير المياه ومطالبة دولتى المجرى والمصب، مصر والسودان بضرورة دفع مقابل مادى لدول المنبع نظير ما يحصلان عليه من حصص مائيه إذا ما ارادا إستمرارها. وذلك عملاً بمبدأ هارمون الذى ينص على السيادة المطلقة للدول على الجزء المار بإقليمها من المجرى المائى الدولى، وهو المبدأ الذى يتعارض مع حقائق الجغرافيا والمناخ وثوابت القانون الدولى والأعراف الدولية.
أما عن الموقف المصرى - السودانى فى شأن مسألة بيع المياه فينعقد إجماع الرأى لدى الخبراء والمسئولين فى مصر والسودان على رفض بيع المياه ورفض إعتبارها سلعه اقتصاديه لما لها من بعد إجتماعى خطير، وهو الأمر – أى مسألة بيع المياه – الذى قد يكون له تداعيات سلبية على الاستقرار الاقليمى فى دول النظام الاقليمى لحوض النيل إذا ما تم التسليم به، وقد أكدت مصر موقفها هذا فى العديد من المحافل الدولية. حيث أن توزيع المياه فى حوض النيل يعتمد فى المقام الأول على تاريخ استخدام دول الحوض للمياه المترتب بدوره على احتياجات تلك الدول، وحاجة السكان والافتقار لمصادر مياه بديله وكافية. كما أن مسألة التفكير فى بيع المياه تعنى أن أحد الأطراف لديه فائض من المياه وليس فى حاجه إليه، وهو الافتراض غير القائم فى دول حوض النيل. كما أن ظاهرة تدفق المياه من المنابع الاستوائية والاثيوبيه نحو دول المجرى والمصب، هى ظاهره طبيعية بحته لا يوجد بها أى تدخلات بشريه أو صناعية، وهو ما يجعل من المياه التى تصل الى دول المجرى والمصب حقًا طبيعيًا لتلك الدول. فضلًا عن أنه لو صح منطق بيع المياه الذى تتبناه بعض دول المنابع فى حوض النيل، فمن شأن ذلك أن يعطى الحق للدول التى تأتى منها الرياح ذات الضغط المرتفع المسببه للأمطار فى دول المنابع بالمطالبه لمقابل مادى نظير تلك الرياح، وهى العمليه التى تخالف المنطق إجمالاً وتفند منطق بيع المياه برمته.
كما أن مسألة بيع المياه من شأنها أن تشعل الصراعات المستقبلية بين الدول أطراف العملية التجاريه على عكس ما هو متوقع منها. إذ أن الدوله المصدره للمياه والتى لديها فائض منها من المتوقع أن تزيد احتياجاتها المائيه مستقبلًا نتيجة للزيادة السكانية والحاجات التنموية، ومن ثم تُقصر المياه على حاجاتها التنمويه وتمتنع عن توريدها للدوله الأخرى المستورده والتى رتبت حاجاتها المستقبلية والتنموية على هذه المياه وهو الأمر الذى من شأنه زعزعة الاستقرار بين الدولتين.
وأخيرًا فقد كان موضوع تقاسم المياه وقضية بيع المياه أحد أوجه الخلاف التى يدور حولها الصراع المائى فى النظام الإقليمى لحوض نهر النيل محدود الموارد المائية بطبيعته. إذ إنه رغم وجود الكثير من الاتفاقيات المائية الدولية التى تنظم الانتفاع بمياه الأحواض النهرية الدولية المشتركة إلا أنها إتفاقيات نسبية تقتصر فى أحكامها على أطرافها ولا تتمتع بطابع العمومية والتجريد. كما أن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997 إتفاقية أطارية فى حقيقتها وغير ملزمه للدول، ولا توجد قاعدة عامة مجردة يمكن الإحتكام إليها عند تقاسم المياه فى الأنهار المشتركة. ورغم أن قواعد هلسنكى واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 قد جاءا بعدد من المعايير لتقاسم المياه إلا انها لا تزال محل خلاف بين الدول فى ترجيح احداها واعطاء الأولوية لبعضها وإنكارها على البعض الآخر.
.......................................................



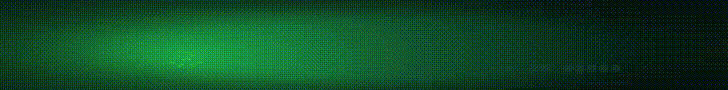

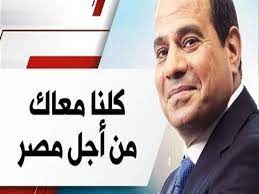
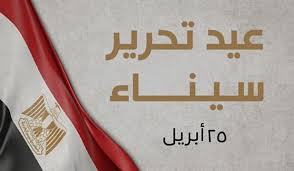












 حكم جديد بالبراءة يرسى قواعد هامه .. نجاحات قانونيه تضاف للمساعد والخبير
حكم جديد بالبراءة يرسى قواعد هامه .. نجاحات قانونيه تضاف للمساعد والخبير تموين كفرالشيخ يشن حملات على الاسواق
تموين كفرالشيخ يشن حملات على الاسواق «مستانف الإسماعيلية » تقضي بإلغاء حكم السجن المشدد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة
«مستانف الإسماعيلية » تقضي بإلغاء حكم السجن المشدد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة خروج الفتيات المصابات باختناق في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية
خروج الفتيات المصابات باختناق في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لقاء الرئيس السيسي والأمير بن سلمان يؤكد قوة الشراكة المصرية السعودية
لقاء الرئيس السيسي والأمير بن سلمان يؤكد قوة الشراكة المصرية السعودية الرئيس السيسي يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
الرئيس السيسي يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 جوائز رئيسية يقدمها مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب
4 جوائز رئيسية يقدمها مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب البطولة الرمضانية: مباراتان فاصلتان اليوم لحسم الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة
البطولة الرمضانية: مباراتان فاصلتان اليوم لحسم الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة