قراءة في قصيدة ”رثاء المطر المعلق” للشاعرة منال رضوان
د. محمد سعيد شحاتة: المطر المعلّق: بنية اللغة بين الخفاء والاكتمال في جدل الوجود والمعرفة


تُعدّ قصيدة "رثاء المطر المعلّق" نموذجًا متميّزًا للشعر المعاصر الذي يسعى إلى توسيع أفق القول الشعري ليصبح فضاءً فلسفيًّا ومعرفيًّا في آن واحد؛ فهي لا تنتمي إلى التعبير الوجداني المباشر بقدر ما تنتمي إلى ما يمكن تسميته بالشعر التأمّلي الذي يُخضع اللغة لتجربة الوعي، ويجعلها وسيلةً لاستكشاف الوجود، ويقوم النصّ على منظومة رمزية كثيفة تتشابك فيها الحواسّ والمجرّدات، ويتداخل فيها الزمن بالحلم، فيتحوّل القول الشعري إلى تجربة إدراكية تحاول إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والعالم والمعنى، ومن هذا المنظور تمثّل القصيدة مجالًا خصبًا للتحليل اللغوي والفكري؛ لأنها تتيح دراسة مستوياتها البنيوية والجمالية والأنطولوجية بوصفها مكوّنات متكاملة في تشكيل التجربة الشعرية.
وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الآليات البنيوية والدلالية التي أسّس بها الشاعر عالمه النصّي، وتسعى من خلال قراءة متعددة المستويات إلى الإحاطة بجوهر التجربة لا بسطحها التعبيري، فقد قُسِّم البحث إلى مجموعة من المحاور التي تعالج الظواهر الأسلوبية والفكرية في القصيدة على نحو متكامل: تناول المحور الأول البنية التصويرية–الاستعارية؛ للكشف عن آليات تشكّل الصورة بوصفها بنية معرفية لا جمالية فحسب، وتناول المحور الثاني البنية النحوية–الإيقاعية؛ لبيان الدور التركيبي في إنتاج المعنى وإيقاعه الداخلي، أما المحور الثالث/البنية الحجاجية–الفكرية فقد ركّز على البعد الفلسفي للخطاب الشعري بوصفه نمطًا من التفكير الجمالي، بينما حلّل المحور الرابع بنية الزمن وتحوّلات الوعي للكشف عن تحوّل الزمن من إطارٍ سردي إلى مفهوم أنطولوجي، ثم جاء المحور الخامس حول البنية الصوتية والإيقاع الداخلي مبيّنًا كيف يتحوّل الإيقاع إلى تجسيد للوعي المتكسّر، تلاه المحور السادس المعنون بالبنية الرمزية والميتافيزيقا الشعرية؛ لتحديد شبكة الرموز الكبرى ووظائفها الفكرية، واختُتمت بالمحور السابع جدلية الذات والكون في البنية الرؤيوية الذي أبرز تحوّل الذات من فاعل لغوي إلى وعيٍ كونيٍّ مندمج في بنية الوجود.
إنّ هذه الدراسة تسعى إلى مقاربة النصّ مقاربةً شمولية تكاملية تتجاوز حدود التحليل الجزئي لتقدّم رؤية منهجية تربط بين الجماليات اللغوية والفكر الفلسفي الكامن في الخطاب الشعري؛ فالقصيدة، بما تحتويه من كثافة لغوية وتوتر دلالي، تمثّل نموذجًا لما يمكن تسميته بـالشعر المعرفي، الذي تتأسّس فيه التجربة الجمالية على الوعي الوجودي، ومن ثمّ فإنّ هذه الدراسة لا تتعامل مع النصّ بوصفه مادةً وصفية أو عاطفية، بل باعتباره فضاءً للبحث في إمكانات اللغة كأداة للفكر والتجلّي، وحقلاً يُختبر فيه الحدّ الفاصل بين القول والمعنى، وبين الإنسان والكون، وبين الشعر والفلسفة.
مهاد أوليٌّ
ينهض النص على لغةٍ عالية التوهّج، تتجاوز المباشر الحسيّ إلى التجريد الميتافيزيقي؛ حيث يُرثى "المطر المعلّق" لا كظاهرة طبيعية، بل كرمزٍ لتوقٍ روحيّ مكسور، يراوح بين الخلق والانطفاء، وتبدأ الشاعرة بانفلات الضوء من "وترٍ خفيّ" ليعلن ميلادًا مرتبكًا للمعنى، وكأنّ الوجود نفسه يحاول أن ينطق فيتعثر، وتكرار فعل الانفلات، والتكسّر، والتلعثم، والانسحاب يشي بأنّ اللغة عاجزة عن احتواء التجربة، وأنّ "الفكرة" تتراجع خشية الاكتمال؛ لأن الاكتمال يعني نهايتها، وهذا الانكسار الداخلي يُحيل إلى جدلية الخلق والمعرفة، فالكلمة تُولد من الصمت، لكنها تخاف أن تصير صوتًا صريحًا، ولذلك تختار الغياب على التعيين، وفي هذا المستوى يتحوّل النصّ إلى مرثية للوجود المؤجَّل، وللفكر الذي لا يكتمل؛ لأنه يعي تمامًا هشاشته أمام "حافة الوعي".
ويتكثّف البعد الفلسفي عبر مشهدٍ كونيّ تتأمّل فيه الجمادات، فالأحجار تنصت بوعيٍ ميتافيزيقي، وتدرك أن "الثقل صلاة للأرض" عبارة تكشف رؤية صوفية ترى في السقوط طاعةً وفي الهبوط حنينًا إلى الأصل، فحتى الضوء، رمز الكشف، "يقف يتأملني" ليعيد السؤال حول ماهية الوعي، هل هو ما نراه أم ما يظلّ متخفّيًا؟ وفي هذا الحيّز يتحوّل المطر إلى استعارة للكشف المعرفي، لكنه "معلّق"؛ لأن الأرض لم تتعلّم بعد "هيئة الارتواء" أي أنّ الإنسان لم يبلغ بعد نضج التلقّي، ولم يتعلّم كيف يفهم النعمة، والسماء التي نسيت "معنى البكاء" رمز لفقدان البُعد العاطفي أو تراجع الحسّ الإنساني.
وهكذا تختم الشاعرة بنبرة رؤيوية تجمع بين الحيرة والرجاء، حيث يصبح الخلقُ نفسه سؤالًا، ويغدو الشعر محاولة دائمة لكتابة نص آخر لا ينتهي؛ لأن اكتماله يعني موتَه.
البنية التصويرية/الاستعارية
في هذا النص تتجلّى البنية التصويرية/الاستعارية بوصفها المعمار الأعمق الذي يحمل الفكرة؛ إذ تُبنَى التجربة على تحويل المحسوس "الضوء، الغبار، الحجر" إلى كائنات دلالية تتكلّم وتخاف وتُنصت، وتقوم الشاعرة بتأسيس حقول دلالية متداخلة، النور/اللغة/الولادة من جهة، والثقل/السقوط/الطاعة من جهة أخرى؛ لتجعل الصورة مجرى تفكير لا زينة بلاغية، تقول:
ينفلتُ الضوءُ من وترٍ خفيّ
يتكلّمُ.. فلا أراه
تُهيّئ الشاعرة قارئها لنقلة من الفيزيائي إلى الماورائي؛ فالضوء الذي يُرى عادةً يصبح هنا صوتًا يُسمع ولا يُرى، فتُعكّس البداهة الحسّية، ويجمع التركيب بين فعليْن دالّين على الانفلات والنطق، ثم تفاجئنا الجملة الاعتراضية "فلا أراه"، وهذا الانتقال من الرؤية إلى السماع يشي بأن المعرفة لا تتمّ عبر الحواس وحدها، بل عبر عبور دلالي يبدّل وظائفها، ومن الناحية البلاغية فإن "وتر خفيّ" استعارة تكثّف توتّر الوجود قبل التلفّظ، والضوء مشدود كآلةٍ موسيقية لا تُرى أوتارها، وما إن "ينفلت" حتى يَتَحوّل إلى قول، ولكنه قول يظلّ خارج مرمى العين، وهكذا تُسقط الصورة مقولةً فلسفية: المعرفة سابقة على الظاهر، واللغة تجلٍّ لخفاءٍ لا يُدرك بكماله، وتقول:
في رحمِ المعنى
تنبضُ فكرةٌ خشيةَ الاكتمال
تستعير الشاعرة بنية الجسد "الرّحم/النبض" لتُجسّد ما لا جسد له "المعنى/الفكرة"، فتنقلنا من مادة اللغة إلى مادّية بيولوجية تُقنع العقل بحقيقة ما لا يُرى، و"رحم المعنى" تركيب إضافي يقيم نسبًا بين دالّ ومدلول، كأنّ المعنى أمٌّ تحتضن جنينًا هو "الفكرة"، لكن الخوف من "الاكتمال" يفتح أفقًا صوفيًا؛ فكلّ اكتمال نقص؛ لأنّه يضع حدًّا للتوالد، ومن الناحية النحوية نصب «خشيةَ» مفعولًا لأجله يربط السبب بالمسبّب؛ لتغدو البنية النحوية جسرًا منطقيًّا بين نموّ الفكرة وتردّدها، ودلاليًا هي أطروحة في فلسفة المعرفة، الحقيقة تتشكّل على حافة الاكتمال، وتنجو بتأجيله.
وتقوم البنية النحوية/الإيقاعية على تدفّق جملٍ فعلية قصيرة متعاقبة، تقطعها وقفات وشرطات وأقواس، بما يشبه "نَفَسًا كتابيًا" متقطّعًا يوازي تعثّر المعنى نفسه، والمضارع هو زمن الغلبة؛ لأنه زمن الحدوث المستمر لا الماضي المنقضي، تقول الشاعرة:
تتكسّرُ على جدارِ الهواء
اعترافُ الوجودِ بعثرةٍ أخرى
صدىً يحاولُ أن يتلعثمَ صوتًا
نحن بإزاء سلسلة من المرايا النحوية: خبرٌ يتعدّد، وبدلٌ يشرح، وتراكم إضافات يمدّ المعنى كأنّه موجٌ يكسّر نفسه على "جدار الهواء"، ويبدأ بالفعل المضارع "تتكسّرُ" ليشي بديمومة الحركة، ثمّ تردّ الجملة الاسمية "اعترافُ الوجود" لتثبّت حركةً في هيئة تقرير، قبل أن يجيء "صدىً يحاولُ" يشرح الاعتراف ويفكّكه، والإيقاع يتولّد من التناوب بين الفعلية/حركة، والاسمية/ثبات مما يخلق اهتزازًا بين التدفّق والوقفة، وهذا التناوب يترجم فلسفيًا توتّر الوجود بين الفيض والتعيّن؛ فالوجود "يعترف" لكن اعترافه "صدى" لا أصل، و"يحاول أن يتلعثم صوتًا" أي أنّ اللغة تظلّ أثرًا، لا جوهرًا.
ما كان (...)
ما سيكون (...)
نُدخِل الشاعرة أقواس الحذف لتجعل الصمت وحدةً لغوية، بحيث يصير الفراغ مكوّنًا نحويًا لا زينة طباعية، والجملتان المقتضبتان تُنشئان تناظرًا زمنيًا: ماضٍ/مستقبل تُفرغه الأقواس من محتواه، فتغدو القدرة على التلفّظ معدومةً عمدًا، والإيقاع هنا ليس صوتيًا فحسب، بل هو بصري أيضًا، وتتوالى الأقواس كعلامات نبضٍ على تخطيط كهربائي للمعنى، ومن الناحية الفلسفية فإن هذا التماثل المحذوف يقرّر أنّ ما نعجز عن قوله في الماضي سنعجز عن إتمامه في المستقبل، وأنّ اللغة تُدير النقص بوصفه مبدأ تكوين، لا خللًا عارضًا، ومن هنا تأتي إعادة الأمر "فلنكتب نصًا آخر" بوصفه عودة إيقاعية تُصرّ على التأسيس من جديد؛ لأن القول الكامل ممتنع.
وأخيرًا تتأسّس البنية الحِجاجية–الفكرية على جدلٍ يقلب البداهات، فالثقل صلاة، والسقوط طاعة، والهبوط حنينٌ إلى المركز، فيما الضوء يتأمّل، لا ينكشف فحسب، والوعي ليس ما نرى، هذا الانقلاب في القيم يصنع حُجّة وجودية، وهي أن الحقيقة ليست في الأعلى الشفّاف، بل في عودة الأشياء إلى أصولها، تقول الشاعرة:
تُنصتُ الأحجارُ بانتباهٍ ميتافيزيقي
تعرفُ أن الثقلَ صلاةٌ للأرض
وأن السقوطَ نوعٌ من الطاعة
كلُّ هبوطٍ قياسُ الحنين إلى مركزه
تنقل الشاعرة خاصّية الوعي من الإنسان إلى الحجر، فينسف تراتبيّة العاقل/الجامد، ويؤسّس برهانًا شعريًا، مؤداه: إذا كان الحجر، وهو أكثر الكائنات ثِقلاً، هو الأعرف بقانون الجذب، فبذلك تكون معرفته طقس عبادة، ومن الناحية النحوية تتوالى الأفعال المضارعة "تُنصت/تعرف"؛ لتثبيت فعل إدراكي دائم، وتتراكب الجمل المصدّرة بــ"أنّ" لتوليد منطق استدلالي داخلي، ومن الناحية البلاغية فإن "الثقل صلاة" استعارة مبدِّلة تُسمّي الضرورة الفيزيائية "عبادة"، و"السقوط طاعة" يجعل الانقياد لقانون الجاذبية مثالًا على عودة الكائن إلى "مركزه"، وهنا "القياس" أداة معرفية: الهبوط معيار حبّ الأصل، ومن الناحية الفلسفية يشي هذا البنيان بأن الحرية لا تُفهم ضدّ الضرورة، بل عبر موافقتها، وأن الكينونة تكتمل حين تؤول إلى مركزها، وتقول الشاعرة:
ابْقَ معلّقًا
فالأرضُ ما زالت تتعلّمُ هيئةَ الارتواء
والسماءُ ما عادت تذكُر معنى البكاء
يخرج الصوت الآمر من منطقة السارد إلى مقامٍ رسولي يخاطب المطر كقوّة كاشفة، لكنّه يأمره بالتأجيل، والمعلّق هو الحقيقة المؤجّلة، ومن الناحية التركيبية فإن فاء السببية تبيّن تعليل الأمر، والتعليق ضرورة تربوية؛ لأن الأرض/الإنسان/الوجود لا تزال في طور التمرّن على استقبال العطاء/هيئة الارتواء، والسماء فقدت ذاكرة الرحمة البكاء، ومن الناحية النحوية فإن الجمل الاسمية تُقنّن الحال وتثبّته، فيما يعطي المصدر "هيئة" للارتواء ملامح بنية قابلة للتعلّم، ومن الناحية الدلالية نحن أمام مفارقة؛ إذ يُطلب إلى الوحي أن يؤخِّر نزوله كي يهيّئ قابلية التلقّي، ومن الناحية الفلسفية فإن هذا يسجّل أطروحة النصّ، وهي أنّ المعرفة ليست فيضًا أعمى بل هي عهدٌ بين المُعطي والمتلقّي، فإذا اعتلّت الذاكرة العلوية وارتجّت الهيئة الأرضية، كان التعليق شرط الخلاص، وكانت الكتابة دائمًا "نصًا آخر"
بنية الزمن وتحوّلات الوعي في النص الشعري
هذه الزاوية البحثية تكمل ما سبق من تحليل للبنية اللغوية والإيقاعية والحجاجية؛ إذ تتجه إلى تفكيك علاقة النص بالزمن، لا بوصفه إطارًا سرديًّا فحسب، بل كعنصرٍ معرفيّ تتجلّى فيه أزمة الوعي والوجود؛ فالزمن في "رثاء المطر المعلّق" ليس خطًّا متتابعًا بين الماضي والمستقبل، بل هو دائرةٌ تتكثّف فيها لحظة الإدراك، وتتأرجح بين الفعل المنقطع والانتظار المعلّق، ومن هنا يصبح لفظ "الآن" الذي تفتتح به الشاعرة النص في قولها "الآن.. ينفلت الضوء" لحظة ولادة واحتضار معًا، تُختزل فيها حركة الخلق والوعي، ويُعاد فيها تعريف العلاقة بين الإنسان والعالم، ومعنى ذلك أن هذه الزاوية البحثية تكشف عن البنية الزمنية العميقة التي تؤطّر كلّ المستويات اللغوية والفكرية في النص، كما تربط بين البنية اللغوية والرؤية الفلسفية، مُظهِرة أن تعليق المطر ليس وصفًا بلاغيًا، بل هو تجسيد لتوق الإنسان إلى لحظة وعيٍ لا تقع في الماضي ولا في المستقبل، بل في حدٍّ بينهما، حيث يُخلق الشعر بوصفه زمناً بديلاً.
يقدّم النص بنيةً زمنية متفلِّتة من الترتيب الخطيّ المألوف؛ إذ يُلغى فيه التمييز الصارم بين الماضي والحاضر والمستقبل، ليصبح الزمن ذاته تجربة شعورية متداخلة، تتبدّل تبعًا لاهتزاز الوعي في لحظة الإدراك، فالافتتاح بقولها "الآن.. ينفلت الضوء" لا يشير إلى زمنٍ محدّد، ولكن إلى لحظة كونية مُعلّقة بين الصفر والاكتمال، لحظةٍ تلتقي فيها البداءة والنهاية، وهذا "الآن" ليس آنًا زمنيًّا، ولكنه حدث أنطولوجي، يعلن انشقاق الوجود عن صمته؛ فالضوء حين "ينفلت من وترٍ خفيّ" يوقظ الزمن الكامن في الأشياء، فيتحوّل الحدث الشعري إلى ميلادٍ مستمرٍّ للمعنى، ومن خلال هذا الانفلات تتكرّر ثنائية الميلاد/الغياب التي تغذّي النص من داخله، فكلّ لحظة خلقٍ تُقابلها خشية الاكتمال؛ لأن الاكتمال يقتل الزمن الذي تتغذّى عليه الكلمة، إنّ بنية الزمن هنا إذن هي زمن الإمكان، حيث يتحقّق المعنى في لحظة توتّره، لا في لحظة استقراره.
يتكثّف هذا الوعي الزمني في صورة "المطر المعلّق"، التي تتجاوز معناها الطبيعي لتصبح رمزًا لزمنٍ مؤجَّل، زمنٍ يتردّد بين الفعل والانتظار، والمطر لا يهطل، لكنه أيضًا لا ينقطع، إنه معلقٌ في حالة برزخية بين السماء والأرض، وبين الإرادة والتردّد، وبين الكشف والكتمان، وفي هذا التعليق يكمن عمق التجربة الإنسانية، فالمعرفة مثل المطر لا تهطل على من لم يتأهّب بعد لتلقّيها، ولهذا تقول الشاعرة "ابْقَ معلّقًا؛ فالأرضُ ما زالت تتعلّم هيئة الارتواء" فالتعليق هنا ليس عجزًا بل حكمة كونية؛ فالأرض بحاجة إلى نضجٍ روحي لتستوعب فيض المطر، كما يحتاج الإنسان إلى نضجٍ معرفي ليحتمل ثقل الحقيقة، فالزمن المعلّق إذن هو زمن التهيّؤ، اللحظة التي تسبق الانبثاق، وهي لحظة توترٍ داخلي تعيشها الكائنات حين تدرك أن الفيض ليس حقًا بل استحقاقًا، وهكذا يصبح المطر رمزًا للمعرفة المؤجّلة، ويغدو التعليق فعل رحمة كونية يؤجّل الكشف حتى يُستعاد التوازن بين الوعي والوجود.
أما في المستوى الأعمق، فإنّ النص يقيم زمنًا دائريًا تتقابل فيه عبارتا "ما كان (...) ما سيكون (...)"، فيتلاشى الحدّ الفاصل بين الماضي والمستقبل، ويُختزل الزمن في وعيٍ حاضرٍ دائم يعيد إنتاج ذاته، والأقواس التي تحيط بالجملتين ليست علامات حذف فحسب، بل هي أيضا رموزٌ لصمتٍ يحتضن المعنى ويعيده إلى دائرة البدء، وهذا الزمن الدائريّ يعبّر عن رؤيةٍ فلسفية ترى أنّ كلّ وجودٍ هو رجعٌ لوجودٍ سابق، وأنّ كلّ معرفة هي تذكّر، لا اكتشاف، إنّ الشاعرة في قولها "فلنكتب نصًّا آخر" لا تبدأ كتابة جديدة، بل تعيد الكتابة الأولى في شكلٍ آخر؛ لأنّ الزمن في عالمها لا يتقدّم بل يدور، ومن هنا تكتسب الكتابة وظيفة خلاصية؛ فهي وسيلة الوعي للنجاة من ثقل الزمن الخطيّ عبر تحويله إلى دائرة تأمّل متجدّدة، وبذلك يغدو الشعر، في جوهره، محاولةً دائمة لتوقيف الزمن عند لحظة الكشف؛ ليظلّ المطر معلقًا أبدًا، في انتظار أن تنضج الأرضُ لارتوائها، وينضج الوعي لإدراك ذاته في مرآة الوجود.
البنية الصوتية والإيقاع الداخلي بوصفهما تجلّيًا للوعي المتكسّر
بعد أن تمّ تحليل اللغة، والبنية النحوية، والحجاج الفلسفي، والزمن، تأتي هذه الزاوية التحليلية لتبرز كيف تُسهم الموسيقى الداخلية للنصّ، من تكرارٍ، وإيقاعٍ، وصمتٍ، وتقطيعٍ صوتيّ، في التعبير عن التجربة الفكرية والروحية، فالشاعرة لا تكتفي بتوليد المعنى عبر المفردة أو الصورة، بل تنسج إيقاعًا متذبذبًا يتماهى مع اهتزاز الوعي ذاته.
تنهض البنية الصوتية في النص على إيقاعٍ داخليّ لا يُبنى على الوزن الخليليّ أو التفعيلة الصارمة، بل على تجاور الصمت والنغمة، والانقطاع والوصل، والنَفَس والفراغ، بحيث يصير الإيقاع نفسه مرآةً لاهتزاز الوعي الذي يعي ذاته بالانكسار، فالشاعرة توظّف علامات الترقيم "النقاط، والأقواس، والفواصل القصيرة" كعناصر إيقاعية لا نحوية فحسب؛ لتجسيد التردّد البنيويّ الذي يسكن التجربة، ويظهر ذلك في قولها "ينفلت الضوء من وترٍ خفيّ، يتكلّم.. فلا أراه" حيث تتحوّل النقطتان والفاصلة إلى مسافات زمنية للوعي، لا مجرّد علامات كتابية، فالفعل "ينفلت" يعقبه سكون قصير قبل أن يُستأنف بقولها "«يتكلّم"، مما يمنح الجملة وقعًا يشبه الارتجاف أو التنهيدة، وكأنّ اللغة نفسها تتردّد بين أن تُقال أو تُحجب، ثمّ تأتي النقاط الثلاث "..." لتجسّد ارتباك النطق، وتعلن أن القول لم يكتمل بعد، بل ما زال في طور التشكل، وبهذا المعنى يتحوّل الإيقاع من عنصرٍ موسيقي إلى أداة معرفية؛ لأنه يُترجم التوتّر الداخلي للوعي وهو يراقب انبثاق نفسه من الصمت.
يتعمّق هذا البعد الإيقاعي من خلال التكرار الصوتي والدلالي، الذي لا يخدم التوكيد البلاغي فحسب، بل يبني زمنًا دائريًا للنصّ يعيد الأفعال والمشاعر في حلقةٍ من التردّد والانتظار، والأفعال المضارعة المتكرّرة مثل "ينفلت، يتكلّم، تنبض، تنسحب، تُنصت، تعرف، يقف" تحافظ على إيقاعٍ نابضٍ بالحركة الدائمة التي لا تنتهي إلى قرار، فاختيار المضارع يخلق موسيقى من الاستمرار واللااكتمال، تمامًا كما يخلق المطر المعلّق زمنًا مؤجّلًا لا هو في السقوط ولا في التوقّف، وكذلك فإنّ تكرار الأصوات المجهورة "القاف، والطاء، والغين" يمنح القصيدة طابعًا جرسيًّا متثاقلاً يتماهى مع رمزية الثقل والسقوط في النصّ "الثقل صلاة، السقوط طاعة" ومن جهة أخرى، يخلق حضور الحروف المهموسة "السين، الشين، الفاء" ملمحًا من الانسياب الخافت، وكأنّ اللغة تتنفس بصوتٍ خفيض يليق بسرٍّ لا يُفصح عنه، وهذا التناوب بين الجهر والهمس يوازي صراع الضوء والظلال في عالم النص، حيث الإيقاع يُحاكي حركة الوعي المتردّد بين الكشف والسكوت.
أما الصمت فهو البنية الإيقاعية الأعمق في القصيدة؛ إذ لا يقلّ حضورًا عن الصوت، والأقواس الفارغة "(...)" والفراغات بين المقاطع، ليست سهوًا، بل هي اختزالٌ لمرحلةٍ فيزيائية من الخلق، حين يسكت الوجود ليلد لغته، فالصمت هنا ليس نفيًا للصوت بل شرطًا له، إنه نَفَس اللغة في لحظة ولادتها، فعندما تكتب الشاعرة "ما كان (...) ما سيكون (...)" نسمع في الفجوات صدى الفكرة قبل أن تنطق، كما لو أنّ الوعي يراجع نفسه في لحظة زمنية لا تُقاس، والإيقاع في هذه المقاطع يتكوّن من الحذف لا من اللفظ، ومن الغياب لا من الحضور؛ ليدلّ على أن المعنى الأعظم في النص ليس ما يُقال، بل ما يُسكَت عنه عمدًا، وهكذا يصبح الصوت والصمت وجهين لإيقاعٍ واحدٍ هو إيقاع الوعي المتكسّر، الذي لا يسعى إلى التناغم التامّ بل إلى كشف التوتّر بين الرغبة في البيان والخوف من اكتماله، ومن خلال هذا الإيقاع الداخلي، ينجح النصّ في تحويل الموسيقى إلى فلسفة، والفراغ إلى معنى، والكتابة إلى كينونة تُصغي لصداها وهي تتكوّن.
البنية الرمزية والميتافيزيقا الشعرية
تركز هذه الزاوية التحليلية على شبكة الرموز الكبرى في النص "الضوء، المطر، الأرض، السماء، الحجر..." باعتبارها تجسيدًا لعلاقة الإنسان بالمطلق: وتدرس كيف تتحوّل العناصر المادية إلى كائنات رمزية واعية؟ وكيف يُبنى النصّ كـ"ميتافيزيقا شعرية" تسائل الوجود من خلال اللغة، وتربط هذه الزاوية التحليلية بين التحليل اللغوي والفلسفة الصوفية الكامنة في النص.
يؤسّس النصّ عالمه على منظومة رمزية كثيفة تتجاوز الملموس لتصوغ ميتافيزيقا شعرية، أي رؤية تتعامل مع الأشياء لا بوصفها مكوّناتٍ حسية، بل بوصفها إشارات إلى نظامٍ خفيّ من المعاني، إنّ المطر، والضوء، والأرض، والسماء، والحجر، كلّها عناصر تتشكّل في النص كرموزٍ كونيةٍ تتداخل فيها مستويات الوجود والمعرفة، فالمطر المعلّق ليس ظاهرة طبيعية، بل استعارة للفيض المؤجَّل، وللمعرفة التي تتهيّأ للانسكاب ولا تكتمل، هو وعيٌ معلق بين الخلق والتجلّي، وبين الامتلاء والحرمان، ويمثّل التجربة الإنسانية في سعيها لفهم علاقتها بالمطلق، أما الضوء الذي ينفلت من وترٍ خفيّ فهو رمز للمعرفة الأولى، للّحظة التي تنبثق فيها الفكرة من الغيب إلى الإدراك، لكنه ضوءٌ لا يُرى؛ لأن الحقيقة في هذا العالم لا تُدرَك مباشرة، بل تُلمَح في انكساراتها، ومن ثمّ يصبح النصّ ساحةً للجدل بين النور والعمى، وبين الصحو والارتباك، حيث الرؤيةُ ليست حسّية بل رؤياوية، أي انكشاف روحيّ يتجاوز العين إلى البصيرة.
وفي هذا السياق الرمزي، تتحوّل الأرض والسماء إلى قطبيْ معادلةٍ وجوديةٍ تمثّلان الوعي الإنساني والبعد الإلهي على التوالي، والعلاقة بينهما علاقةُ عطشٍ وتذكّر، تقول الشاعرة:
فالأرض ما زالت تتعلّم هيئة الارتواء،
والسماء ما عادت تذكُر معنى البكاء
هنا لا يعود المطر مجرّد ظاهرة طبيعية، بل رمزًا للصلة المقطوعة بين الخالق والمخلوق، أو بين الأصل والفرع، والأرض كناية عن الكائن المحدود الذي لم يكتمل بعد في قابليته للفهم، والسماء عن الذاكرة العلوية التي نسيت فعل العطاء، إنّ المأساة الكبرى في هذا المشهد الرمزي هي أن الطرفين/الأرض والسماء يعانيان الفقد ذاته؛ فالأرض فقدت الارتواء، والسماء فقدت البكاء، أي فقدتا معًا لغة التواصل، وبذلك يعيد النص بناء الكون على صورة الانفصال: الوعي الإنساني الذي يطلب الكشف، والوعي الكوني الذي نسي كيف يُفيض رحمته، وهذه الثنائية تعبّر عن مأزق الميتافيزيقا الحديثة التي ترى في الصمت الإلهي انعكاسًا لتيه الإنسان نفسه، فيتحوّل المطر إلى رمزٍ للبحث المستمر عن المعنى، لا عن الماء.
أما الحجر والثقل والسقوط فتشكّل رموزًا مكمّلة في هذه البنية الميتافيزيقية؛ فالقول بأن الثقل صلاة للأرض يجعل من الجاذبية قانونًا روحيًّا، ومن السقوط فعلَ عبادة، كأنّ الوجود لا يكتمل إلا حين يعود إلى أصله، وبهذا المعنى تتحوّل الفيزياء إلى لاهوت، وتصبح قوانين الطبيعة صورًا لقوانين الروح؛ فالسقوط ليس هبوطًا، ولكنه حنينٌ إلى المركز، أي عودة الكائن إلى جوهره، وهذه الرؤية تُعيد تعريف العلاقة بين الماديّ والروحيّ، فالثقل هنا ليس عائقًا عن التسامي، بل هو طريق إليه، ومن خلال هذه الرموز المتبادلة تبني الشاعرة نظامًا ميتافيزيقيًا يرى الوجود كتجربة وعيٍ يسعى إلى التوازن بين النور والظلمة، والماء والتراب، والصعود والسقوط، وفي النهاية، حين يخاطب الضوء المطر قائلًا "ابْقَ معلّقًا" فإننا نكون أمام ذروة الرمزية، أي المعرفة تخاطب نفسها، والخلق يحاور خالقه، ليبقى المعنى مُعلَّقًا في منطقةٍ بين الكينونة والاحتمال، وهكذا تتحوّل الرموز إلى لغةٍ كونيةٍ بديلة، وتصبح القصيدة نفسها صلاةً ميتافيزيقية تتلمّس طريقها نحو الحقيقة، لا لتبلغها، بل لتؤكّد أن السرّ يكمن في البقاء في الطريق إليها.
جدلية الذات والكون في البنية الرؤيوية
تتجلّى في نصّ "رثاء المطر المعلّق" جدليةٌ عميقة بين الذات والكون؛ إذ لا يقف الشاعر خارج العالم ليتأمله من علٍ، بل يندمج فيه حتى التماهي؛ ليصير صوته صدىً للأشياء وصداها امتدادًا لوعيه، والذات هنا ليست ذاتًا فردية، بل وعيًا كونيًّا يحاول أن يدرك نفسه من خلال اللغة، فحين تقول "يقف الضوء يتأملني" ينعكس موقع الرؤية، فبدل أن تكون الشاعرة هي الناظرة، تصبح منظورًا إليها، كأنّ الكون هو من يراها ويختبرها، وهذه الحركة الانعكاسية تضع الذات في موضع المرآة، حيث لا يعود الوعي مركزًا ثابتًا بل سيرورةً من الانعكاسات المتبادلة، وفي هذا المستوى تنحلّ الثنائية القديمة بين الإنسان والعالم؛ لأنّ كليهما جزء من منظومةٍ واحدةٍ تتبادل النظر والمعنى، إنّ الشاعرة لا تقول "أنا أرى الضوء" بل "الضوء يتأملني"؛ لتعلن انقلاب العلاقة بين المعرفة والموضوع، فالكائن صار موضوعًا لتأمل الوجود نفسه، وهكذا تتحول التجربة من تعبيرٍ ذاتيّ إلى تجربة كونية تُعيد تعريف الوعي باعتباره صدى لوعيٍ أكبر يسري في الأشياء.
تتّسع هذه الجدلية أكثر حين نقرأ قولها "فلنكتب نصًا آخر" فالأمر بالكتابة ليس موجّهًا من الذات إلى الآخر، بل من وعيٍ كليٍّ إلى نفسه؛ إذ تكتب الشاعرة والكون معًا النصّ ذاته، وهنا يتماهى الفعل الشعري مع فعل الخلق الكوني، وكأنّ الكتابة استمرار للخلق الأول، أو إعادة إنطاقٍ للوجود بالصوت الإنساني، وهذا "النصّ الآخر" هو دعوة لإعادة بناء العلاقة بين الذات والعالم على أساس المشاركة لا السيطرة؛ لأنّ العالم لم يُستنزف بعد في فهمه، بل ما زال ينطق بلغاتٍ غير مفهومة، إنّ تكرار الأمر "لنكتب" يشي بأن الوجود نصّ مفتوح لا يُغلق إلا بالموت، وأنّ اللغة هي الامتداد الطبيعي للخلق، فكلّ جملة جديدة تكتبها الذات هي محاولة لفهم صورتها في مرآة الكون، وكلّ صمتٍ في النصّ هو إصغاء إلى صوت الكينونة في داخلها، ومن هنا تُصبح الكتابة فعلَ عبور بين الذاتيّ والكونيّ، ووسيلةً لمصالحة الأنا مع الوجود؛ لأنّها تتيح للشاعرة أن تكون الخالق والمخلوق في آنٍ واحد.
وعلى المستوى الفلسفيّ الأعمق، تعبّر جدلية الذات والكون عن تجربة وحدة الوجود في شكلها الشعريّ؛ فحين تنصت الأحجار، وتعرف الأرض، ويتكلّم الضوء، وينبض المعنى، فإنّ كلّ موجودٍ في النصّ يشارك في الوعي الكليّ، مما يعني أنّ العالم ليس جمادًا، ولكنه لغةٌ حيّة تتكلّم عبر الكائنات، والذات الشاعرة هي المفصل الذي يتقاطع فيه هذا الوعي الكونيّ مع التجربة الفردية؛ فهي من تمنح الأشياء نطقها، لكنها في الوقت نفسه تُستلب في صوتها؛ إذ ما تقول إلا ما يُقال فيها، لذلك يصبح النصّ تجربة حلولٍ رمزية بين الإنسان والكون، فالمطر المعلّق هو ذاته الوعي المعلّق بين العجز عن الفهم والرغبة في الإدراك، والضوء الذي يتأمل الشاعرة هو البصيرة التي تراها من خارج حدود الوعي الفردي، وفي هذا التبادل تتكشّف الرؤية النهائية للنصّ: الإنسان ليس مركز الكون بل مجراه، واللغة ليست وسيلة لوصف العالم بل طريقة ليتكلم بها العالم من خلالنا، وبهذا تكتمل الدائرة الرؤيوية، فالشاعرة التي بدأت مراقبة لفيضٍ معلقٍ في السماء، تنتهي كائنًا معلّقًا في وعي الوجود نفسه، يكتب كي يواصل المطر الأبديّ حديثه.
خاتمة
خلصت الدراسة، من خلال محاورها المتتابعة، إلى أنّ قصيدة "رثاء المطر المعلّق" تُقدّم نموذجًا دالًّا على التحوّل الذي أصاب الشعر العربي المعاصر، من كونه خطابًا وجدانيًّا إلى كونه خطابًا معرفيًّا فلسفيًّا، يعبّر عن أزمة الوعي الإنساني في علاقته باللغة والوجود، لقد أظهر التحليل أنّ النصّ يرتكز على منظومة متداخلة من المستويات اللغوية والإيقاعية والرمزية والفكرية، تتكامل فيما بينها لتشكّل رؤية شعرية ذات بعد أنطولوجي؛ فالقصيدة تُعيد بناء العالم من داخل اللغة، وتحوّل العلامة اللغوية من مجرّد وسيلة للتعبير إلى أداة لطرح الأسئلة الجوهرية حول الكينونة والمعرفة والزمن، ومن ثمّ فإنّ بنية النص لا يمكن اختزالها في بعدٍ واحد؛ لأنّها تتشكّل من جدلٍ دائم بين الصوت والمعنى، والصورة والفكر، والذات والعالم.
وقد بيّنت المحاور السابقة أنّ الشاعرة تُعيد تعريف مفاهيم مركزية، مثل: النور، والمطر، والأرض، والسماء، والحجر، لتغدو رموزًا لجدلية الكشف والغياب، كما كشفت القراءة الزمنية والإيقاعية عن تحوّل الإيقاع إلى بنية معرفية تُجسّد اهتزاز الوعي الإنساني في سعيه إلى الفهم، وتحويل الزمن إلى دائرة تأمّلية يتقاطع فيها الماضي بالمستقبل داخل لحظة إدراك واحدة، أما على المستوى الرمزي والرؤيوي، فقد أبرز التحليل أنّ القصيدة تنبني على وحدةٍ وجودية ترى في الكون كائنًا واعيًا، وفي الإنسان جزءًا من وعيه الكليّ، مما يمنح النص بعدًا صوفيًّا وفلسفيًّا في آن، وبهذا المعنى فإنّ النصّ يمثّل تجربة لغوية متجاوزة، يتداخل فيها الحدس بالتحليل، والمجاز بالمعرفة، لتغدو القصيدة فضاءً للبحث الوجودي أكثر منها تعبيرًا انفعاليًّا.
إنّ القيمة الكبرى لهذه القصيدة تتجلّى في قدرتها على تحويل الشعر إلى ممارسة معرفية وتأمّلية تُسائل طبيعة الوعي الإنساني ومحدوديته، وتعيد التفكير في وظيفة اللغة ذاتها؛ فهي تضع المتلقي أمام تجربة تتطلّب القراءة البطيئة والمتأنية؛ لأنّها تشتغل على مستويات متراكبة من الدلالة، وتُخضع العناصر الجمالية لتوظيفٍ فلسفيٍّ دقيق، وبهذا يمكن القول إنّ قصيدة "رثاء المطر المعلّق" تمثّل نموذجًا للقصيدة العربية الحديثة التي تُقيم حوارًا بين الفنّ والفكر، وتعيد للشعر مكانته كأداةٍ للمعرفة الوجودية، ومن خلال هذه الرؤية، تفتح الدراسة أفقًا جديدًا للقراءة النقدية التي تتعامل مع النصوص الشعرية لا بوصفها تراكيب لغوية مغلقة، بل كأنساق فكرية مفتوحة على تأويلٍ لا ينتهي، تمامًا كما يظلّ المطر في القصيدة معلّقًا في انتظار أن تكتمل هيئة الارتواء في الأرض، ويكتمل وعي الإنسان بذاته في مرآة اللغة.
رثاء المطر المعلّق
لنكتب نصًا آخر(...)
الآن..
ينفلت الضوءُ من وترٍ خفيّ،
يتكلّمُ.. فلا أراه،
يوقظ الغبارَ من نومِه الأبدي
كليمة كعادتها..
تتكسّرُ على جدارِ الهواء،
اعترافُ الوجود بعثرة أخرى،
صدىً يحاولُ أن يتلعثمَ صوتًا،
يذكُر نقطة..
تتكور في دفترها الأبيض!
في رحمِ المعنى،
تنبضُ فكرة خشية الاكتمال
تنسحب إلى الغيبِ؛
لئلّا تصطدم بحافة وعي
تتركُ خلفها ارتباك الكائن
ما كان(...)
ما سيكون (...)
تُنصتُ الأحجار بانتباهٍ ميتافيزيقي،
تعرفُ أن الثقلَ صلاةٌ للأرض،
أن السقوطَ نوعٌ من الطاعة،
كلُّ هبوطٍ قياس الحنين إلى مركزه
في الدائرةِ المشرعة نحو الفراغ،
يقفُ الضوءُ يتأملني:
الوعيُ ليس ما نراه؛
فلنكتب نصًا آخر
هل خَلْقُ النورِ سؤالٌ؟!
أم رجع يرتد يبحث عن صوته؟
يهمسُ للمطر:
ابْقَ معلّقًا؛
فالأرضُ ما زالت تتعلّمُ هيئة الارتواء،
والسماء ما عادت تذكُر معنى البكاء!



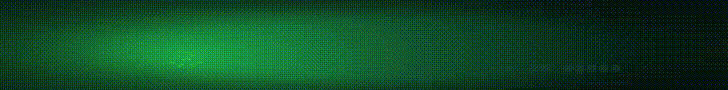












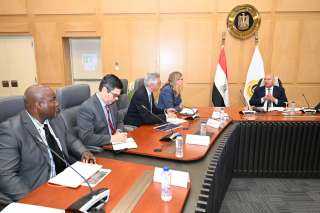




 استجابة سريعة من مديرية أمن سوهاج..ضبط صاحب فيديو إستقطاب الفتيات لممارسة الأعمال...
استجابة سريعة من مديرية أمن سوهاج..ضبط صاحب فيديو إستقطاب الفتيات لممارسة الأعمال... تموين القليوبية تضبط مخالفات كبيرة وتشدد قبضتها على الأسواق
تموين القليوبية تضبط مخالفات كبيرة وتشدد قبضتها على الأسواق مصدر أمني: ضبط إحدى السيدات بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من السيدات
مصدر أمني: ضبط إحدى السيدات بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من السيدات الداخلية ترد على تداول عدد من مقاطع الفيديو تدعي وجود مخالفات أمام...
الداخلية ترد على تداول عدد من مقاطع الفيديو تدعي وجود مخالفات أمام... شرم الشيخ تستضيف أكبر مؤتمر دولي للنحالين بمشاركة 27 دولة وتعزيز ريادة...
شرم الشيخ تستضيف أكبر مؤتمر دولي للنحالين بمشاركة 27 دولة وتعزيز ريادة... د. بكري دردير الأقصري يكتب: ابن الأصول
د. بكري دردير الأقصري يكتب: ابن الأصول مؤسسة حضرموت للثقافة تحتفي بـ (115 عامًا من التأثير) للأديب الراحل علي...
مؤسسة حضرموت للثقافة تحتفي بـ (115 عامًا من التأثير) للأديب الراحل علي...