قراءة سيميولوجية في قصيدة (الزلزلة)


قراءة سيميولوجية في قصيدة (الزلزلة)
1- القصيدة والسياق:
"معرفة السياق وإدراكه عملية ضرورية لتذوق النص وتفسيره" – يقول الغذامي – وهذه قصيدة كتبها الشاعر (منصور عيد)، من قبيلة السواركة، ومن قرية (الجورة) الصامدة. تلك القرية التي ساءت فيها الظروف جدا؛ فنزح معظم أهلها بعيدا إلى قرية (الروضة) التي هي معقل من معاقل الطرق الصوفية في سيناء. وكان الشاعر وأسرته من ضمن النازحين الباحثين عن الأمان، لكنه صُدم في شتاء 2017 صدمة هائلة حين أبيد المصلّون في المسجد خلال صلاة الجمعة؛ فكان الضحايا الأبرياء بالمئات، ومنهم والد الشاعر نفسه الذي رثاه بهذه القصيدة المعنونة بـ (الزلزلة):
ولأنه قص الحكاية مجملة
حسبوه كلّت في يديه الأخيلة
فأشاح عنهم ثم أسند طرفه
تعبا على حجر الزوايا المهملة
فهو المُدان بعجزه.. كفتيلةٍ
أعيا أشعّتها ظلام الزلزلة
سيزيف يدفع صخرةً أبديةً
ويردها للقاع ثقل المهزلة
يا كربلاء ختمتِ مشهد قاتلٍ
بالعود يعبث في الجفون المسبلة
أسدلتِ فوق دم الحسين ستارةً
فمن الذي رفع الستار.. وأكمله ؟!
ما زال يوسف يا أبي في بئره
لا دلو في أفق البشير لينشله
لما أتيتك لاهثاً حمَّلتنى
ما كنت أحسب أنني لن أحمله
ووقفتُ قرب الباب.. قلتُ لعله
كان احتمالاً.. صدقُ نزفك أبطله
و ذرفتُ أسئلةً على دمك الذي
جريانُه فضح المجاز و عطّله
يا عينُ كنتِ على الدوام صموتةً
من أين جئتِ بكل تلك الأسئلة ؟!
2- معالم القراءة السيميولوجية:
تُعنى القراءة السيميولوجية بتتبع (العلامات) في النص، بوصف النص منجزا لغويا، وبوصف اللغة نظاما من العلامات.
والعلامة – في أبسط تعاريفها – هي أداة يستخدمها الإنسان من أجل تبليغ حالة وعي إلى إنسان آخر، أو هي كل شيء أو حدث يحيل إلى شيء ما أو حدث ما. وعليه فإن اللغة هي علامة تحيل المتلقي على تصور ذهني، أو على (شيء) عيني، وَفق الاختلاف الشهير بين الدارسين. وهي – أي اللغة – لا تكون علامة إلا إذا تم تأويلها من لدن مؤول لتدل على صورة ذهنية أو على شيء ما، يكون هو المدلول، ويكون اللفظ ذاته هو الدال، ومن مجموعهما تتكون العلامة.
والعلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة بين الحضور والغياب؛ فاللفظ الدال موجود حاضر أمامنا، لكن المدلول يمثل حالة غياب لأنه يعتمد في استحضاره على ذهن المتلقي. من هنا كان وجود المتلقي المتفاعل شرطا أساسيا بوصفه من يقوم بعملية جلب الغائب وإكمال الناقص؛ لتقوم العلامة على ثلاث علاقات: علاقتها بالشيء الذي تشير إليه، وبغيرها من العلامات، ثم بالمتلقي الذي يفسرها، وهو ما يُسمى بالمثلث السيميولوجي.
نأخذ مثالا من القصيدة هو كلمة: (الزوايا) التي تُعد (دالا) حاضرا يشير إلى مدلولات غائبة ومختلفة وَفق تصور المتلقي الذي قد يراها تشير إلى زوايا الصوفيين، أو إلى زوايا المسجد الذي هُرع إليه الأبرياء لحظة (الزلزلة)، أو إلى زوايا الإهمال الذي قاد إلى (المهزلة)، أو إلى زوايا النسيان التي ستطوي هذه الضحايا (المهملة). وهي الإشارات لا يصل إليها المتلقي إلا من خلال علاقة العلامة/ الزوايا، بغيرها من العلامات التي انبنى منها النص؛ ليكتمل بين أيدينا المثلث السيميولوجي الذي أشار إليه (بيرس).
وإذا كانت العلامات في هذا النص أنواعا مختلفة؛ فإن ترابطها وتضافرها في بنية متماسكة هو ما يعطيها قيمتها الفنية، ويُكسب النص كله وحدة تصونه من التشتت وتضمن له التكثيف والتركيز والتأثير؛ فإن النص في حقيقة الأمر هو تنويع أو توزيع لبنية واحدة، هي بنية (رمزية) تقوم على توظيف رموز عديدة توظيفا يسير في سياق واحد نحو هدف واحد تلخصه الكلمة المفتاح: (المهزلة)، بداية من رمز (الزلزلة) في العنوان، حتى رمز (الصمت) في البيت الأخير.
3- أنواع العلامات السيميولوجية في النص:
3/1- المؤشر السيميولوجي: ويُقصد به إقامة علاقة سببية بين واقعة لغوية وبين شيء تدل عليه هذه الواقعة. فحرف العطف (و) في أول النص واقعة لغوية تشير إلى أشياء كثيرة (مسكوت عنها) سبقت (الزلزلة) ومهّدت لحدوثها. حتى إذا حدثت الكارثة الفظيعة كان لا بد من كلام جاء (قصا) بمعنى (قطع)، لا بمعنى (حكي)؛ لأن الكلام لم يُجدِ ابتداء في منع حدوث الزلزلة؛ فكان السكوت مناسبا قبل وبعد الحدث الجلل.
ثم تتناسل إشارات سيميولوجية أخرى، من إشارة الصمت الأولى (واو العطف) التي عطفت قص الكلام على الصمت؛ فجاءت (أشاح) إشارة أخرى تحيل على عدم الرغبة أو عدم القدرة على الكلام، أو على أن الكلام عبث أمام (ثقل المهزلة). (ثم أسند طرفه) حين البأس؛ فكان حديث الطرف مُغنيا عن حديث اللسان في إشارة محزون لم يتكلم، كما ورد في تراثنا القديم.
3/2- الرمز السيميولوجي: وهو علامة تشير إلى الموضوع الذي تُعبر عنه عن طريق العُرف. فإن (الزلزلة) في ثقافتنا الإسلامية رمز متعارف عليه ليوم القيامة؛ فكأن ما حدث هو القيامة لهوله وبشاعته، أو كأننا نستحضر القول الإسلامي المأثور: "من مات فقد قامت قيامته"؛ فهؤلاء الشهداء دخلوا العالم الآخر حقيقة لا مجازا، وهو ما يشير إليه رمز (الزلزلة).
وانطلاقا من الكلمة المفتاح (المهزلة) نجد رمز (سيزيف) الذي يشير إلى فعل عبثي متجدد يوازي تماما حالة الحرب العبثية المتجددة، ويوازي، على محور قطب التضاد الثنائي، رمز (الزوايا) التي هي شفرة رمزية تصور الطهارة وما يصاحبها من نقاء وجداني، في مقابل رمزية (سيزيف) الذي باع نفسه للشيطان؛ لتتجلى لنا مفارقة مدهشة بين القاتل والمقتول، بين من أغواه الشيطان وبين روّاد الزوايا.
ومن صور (المهزلة) أن (يوسف) تُرك في ظلام البئر لم يجد من ينشله. و(يوسف) هنا تجاوز كونه رمزا دينيا إلى كونه (ثيمة) أدبية تصور ثقل المهزلة. فإذا كان هؤلاء المصلّون العاكفون في زواياهم على العبادة، إذا كانت المهزلة قد قست عليهم؛ فهي على غيرهم أقسى وأشد.
ويأتي رمز (الحسين) رمزا سيميولوجيا متسقا مع مجموع العلامات في النص كله، ورامزا ببلاغة شديدة إلى المهزلة الناتجة عن صراع لا يُقيم وزنا لأية قيمة، ولا يراعي في الأبرياء عهدا ولا ذمة.
3/3- الاستعارة السيميولوجية: وهي علامة بالغة التركيب، عكس العلامات العادية. فهي متعددة المعنى تعددا مستمدا من الإيحاءات، فهي تحيل على مدلول أول يحيل إلى مدلول ثان، وهكذا.
إن النص يؤثر التفاصيل التي تثير تداعيات تقترن كلها بمفهوم واحد هو (ثقل المهزلة). ويستحضر نسقا من العلامات يشير بإصرار إلى هذا المفهوم، ومن هذه العلامات الاستعارة التي تقوم بصهر عالم الشاعر الداخلي ويأسه من عقم العالم الخارجي، "كلّت في يديه الأخيلة"؛ فالضحايا، وتركها لمصيرها، ولا دلو في أفق البشير، كل هذا لا يقوى خيال ولا أخيلة على تصويره، وإنما هي دموع في صورة أسئلة، أو أسئلة في صورة دموع، كلاهما يفيض في صمت غزير مرير، يردنا مباشرة من منتهى القصيدة إلى مطلعها، وكأن النص كله استعارة واحدة مزجت الذات الشاعرة بموضوع المهزلة المأساوية، وكشفت عما يعتمل في داخلها من ألم صامت عميق "فضح المجاز وعطلّه".
لقد جاء النص غنيا بشبكة مترابطة من العلامات السيميولوجية المتنوعة، التي صنعت مشهدا كليا يصور الزلزلة أصدق تصوير، ويُبرز المهزلة العبثية في صورة فنية موحية ومؤثرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهامش: رجعنا في هذه المقالة إلى:
1- أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط أولى، 2005، ص 187
2- أمبرتو إيكو، العلامة، ترجمة علي مولا، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ثانية، 2010، ص ص 56 : 92
3- سيزا قاسم، ونصر أبو زيد، مدخل إلى السيميوطيقا، دار إلياس العصرية، القاهرة، 1986، ص ص 139: 225
4- عبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4، 1998. ص ص 13: 51



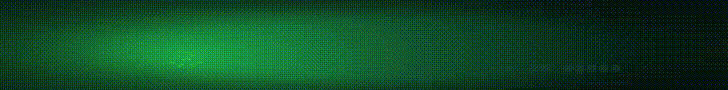

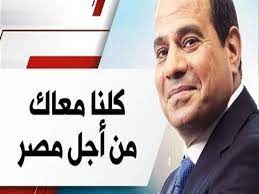
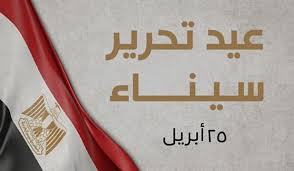

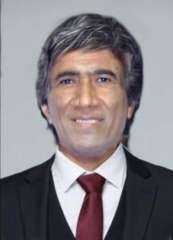










 قنا .. النجار يزلزل الأوكار بالدير الشرقي .
قنا .. النجار يزلزل الأوكار بالدير الشرقي . جثة مجهولة بجوار مشرحة بنها
جثة مجهولة بجوار مشرحة بنها بلاغ جنائي يكشف شبكة فساد داخل نقابة مهنية
بلاغ جنائي يكشف شبكة فساد داخل نقابة مهنية محافظ المنوفية يشيّع جثمان الرائد أحمد حافظ بمسقط رأسه في طه شبرا
محافظ المنوفية يشيّع جثمان الرائد أحمد حافظ بمسقط رأسه في طه شبرا ”١٠٠ يوم صحة” تصل إلى رجال الشرطة في سرس الليان ومراكز المحافظة
”١٠٠ يوم صحة” تصل إلى رجال الشرطة في سرس الليان ومراكز المحافظة جولات ميدانية مكثفة من الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة الصحة و السكان.
جولات ميدانية مكثفة من الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة الصحة و السكان.