أشرف محمدين يكتب: كثيرو الشكوى… صُنّاع النكد ومصدّرو الطاقة السلبية


لا تكاد تخلو حياة أيٍّ منّا من ذلك النموذج المكرّر: أشخاص لا يرون في الدنيا سوى جانبها المظلم، ولا يملّون من التذمّر والأنين. يظهرون في كل مجلس وكأنهم يحملون رسالة واحدة: بثّ النكد وتصدير الطاقة السلبية.
ظاهرة اجتماعية متنامية
يرى خبراء الاجتماع أنّ الشكوى المتواصلة لم تعد مجرد سلوك فردي، بل تحوّلت إلى ظاهرة اجتماعية تنعكس آثارها على المحيطين. فالشخص كثير الشكوى لا يبحث غالبًا عن حل لمشكلاته، بل يكررها بإلحاح حتى يُثقل كاهل الآخرين، ويدفعهم إلى الغرق معه في دائرة الإحباط.
ويشير مختصون إلى أن هؤلاء لا يدركون حجم الضرر النفسي الذي يتركونه خلفهم؛ فهم يستهلكون طاقة الآخرين، ويبددون فرحهم، ويحوّلون الأجواء في العمل أو البيت إلى ساحة حزن لا تنتهي. ومع مرور الوقت، يبدأ الناس في الانسحاب من محيطهم حفاظًا على سلامهم النفسي.
أسباب متشابكة
تتعدد أسباب هذا السلوك؛ فقد يكون ناجمًا عن ضعف الثقة بالنفس، أو هروبًا من مواجهة المسؤولية، أو رغبة دفينة في جذب الانتباه والتعاطف. فيما يذهب البعض إلى أن الأمر قد يكون نتاج تربية خاطئة أو عادة ترسّخت حتى أصبحت جزءًا من الشخصية.
لكن، وبحسب مختصين، فإنّ المؤكد أن كثرة الشكوى لا تغيّر واقعًا، ولا تحل مشكلة، بل تُضاعف الأعباء وتعمّق الإحباط.
أين تكمن المواجهة؟
التسامح المفرط مع كثيري الشكوى قد يحوّل المحيطين بهم إلى أسرى لنكدهم، فيما يفرض الوعي ضرورة وضع حدود واضحة. وهنا يؤكد علماء النفس أن التعامل الأمثل معهم يكون عبر إظهار التعاطف في حدود، مع عدم السماح بأن تتحول آذان الآخرين إلى “مكبّ نفايات عاطفي”.
في زمن يعجّ بالتحديات، باتت الحاجة ملحّة إلى أشخاص ينشرون الأمل لا الإحباط، ويضيئون المكان بابتسامة لا بعبوس. فالحياة مليئة بما يستحق الشكر أكثر مما يستحق الشكوى، والاختيار في النهاية بأيدينا: إمّا أن نسمح لصوت السلبية أن يسرق طاقتنا، أو أن نحيط أنفسنا بمن يزرعون فينا نورًا لا نكدًا.



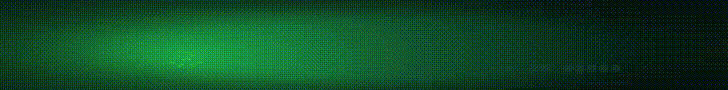















 جثة مجهولة بجوار مشرحة بنها
جثة مجهولة بجوار مشرحة بنها بلاغ جنائي يكشف شبكة فساد داخل نقابة مهنية
بلاغ جنائي يكشف شبكة فساد داخل نقابة مهنية محافظ المنوفية يشيّع جثمان الرائد أحمد حافظ بمسقط رأسه في طه شبرا
محافظ المنوفية يشيّع جثمان الرائد أحمد حافظ بمسقط رأسه في طه شبرا تفحم ربة منزل وطفليها في حريق هائل بمنزل بشبرالخيمة
تفحم ربة منزل وطفليها في حريق هائل بمنزل بشبرالخيمة حماية صحة المواطنين.. ضبط وإيقاف وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمنوفية
حماية صحة المواطنين.. ضبط وإيقاف وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمنوفية منتخب ناشئي السلة يعسكر في رواندا استعدادًا للبطولة الإفريقية
منتخب ناشئي السلة يعسكر في رواندا استعدادًا للبطولة الإفريقية جامعة بنها تنظم 99 قافلة متنوعة ضمن أنشطتها بمبادرة بداية _...
جامعة بنها تنظم 99 قافلة متنوعة ضمن أنشطتها بمبادرة بداية _...