د. أسامة إبراهيم يكتب: حين تُصاب المجتمعات بعدوى القناعات


هل تساءلت يومًا كيف تنتقل فكرة أو إشاعة أو موجة خوف من شخص إلى آخر، حتى تصبح واقعًا لا يُناقش؟ في كثير من الأحيان، لا يكون السبب معلومة مؤكدة أو تحليلًا عقلانيًا، بل مجرد نظرة إلى ما يفعله الآخرون. هذه الظاهرة تُعرف بالتأثير الاجتماعي، وتُظهر كيف يمكن لملاحظات عابرة أو إشارات غامضة أن تُطلِق سلسلة من التفاعلات الجماعية التي تُشكّل في النهاية وعينا ومواقفنا.
في عام 1954، شهدت ولاية واشنطن الأمريكية حادثة غريبة تُعرف بـ"وباء خدوش الزجاج الأمامي". بدأت القصة حين لاحظ سكان مدينة بيلينغهام خدوشًا صغيرة على زجاج سياراتهم، فرجّحت الشرطة أنها نتيجة أعمال تخريب باستخدام كريات BB (ذخائر صغيرة تُستخدم في بنادق الرش). وسرعان ما بدأت شكاوى مماثلة تظهر في مدن أخرى، وارتفع عدد السيارات المتضررة إلى قرابة ألفي مركبة خلال أسبوعين، ما أثار الذعر والقلق. بلغت البلاغات ذروتها عندما اقتربت "الظاهرة" من سياتل، فدخلت الصحف على الخط، وتلقّت الشرطة مئات البلاغات الجديدة. بعض السكان أشار إلى ظواهر جوية غريبة، وآخرون تحدثوا عن موجات صوتية، أو تغير في المجال المغناطيسي للأرض، بل وصلت التفسيرات إلى الأشعة الكونية. وفي 16 أبريل، تجاوز عدد البلاغات ثلاثة آلاف، فاستغاث عمدة المدينة بالحكومة الفيدرالية، معتبرًا أن الأمر خرج عن السيطرة. شُكّلت لجنة علمية للتحقيق، وكان الاستنتاج صادمًا: لا وجود لخطر جديد. فالخدوش كانت ناتجة على الأرجح عن ظروف القيادة المعتادة، ولم تكن السيارات الجديدة متأثرة. وخلصت اللجنة إلى أن "الخدوش كانت هناك طوال الوقت، لكن لم يلحظها أحد إلا الآن". وهكذا تحوّلت حادثة بسيطة إلى قناعة جماعية مضلّلة، بفعل مزيج من المبالغة الإعلامية والعدوى النفسية.
بعد ستين عامًا، شهدت ولاية كولومبيا قصة مشابهة ولكن بصيغة صحية. في عام 2012، أطلقت الحكومة برنامجًا وطنيًا لتطعيم الفتيات المراهقات ضد فيروس الورم الحليمي البشري(HPV). وحقق البرنامج نجاحًا باهرًا في عامه الأول، إذ وصلت معدلات التغطية إلى 98% للجرعة الأولى. لكن في عام 2014، ظهرت لدى عدد من الفتيات في إحدى المدارس أعراض بدنية غامضة بعد تلقي اللقاح، مثل التشنجات، والإغماء، فنُقلن إلى مستشفى محلي. لم تمضِ أيام حتى بدأت مقاطع فيديو تُظهر هذه الأعراض تنتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل والصحف الوطنية. وما إن تكرّرت المشاهد حتى استدعت الخوف الجماعي الكامن، وبدأت البلاغات تتزايد بسرعة، حتى سُجّل ما يزيد على 600 حالة مماثلة في مناطق مختلفة من الولاية. ومع أن السلطات الصحية أكدت بعد الفحص والتحقيق أن اللقاح لم يكن السبب، وأن ما حدث هو استجابة نفسية- وهي ظاهرة موثقة طبيًا تحدث عندما تتجسد الضغوط النفسية في شكل أعراض جسدية ضمن بيئة متوترة – فإن هذا التفسير لم يُهدّئ من مخاوف الجمهور. بل على العكس، تراجعت الثقة العامة في اللقاح، وتحوّل القلق الفردي إلى قناعة اجتماعية متضخّمة. وبحلول عام 2016، انهارت معدلات التطعيم إلى 15% للدورة الكاملة. مجرد سلسلة من الانطباعات غير المؤكدة، غذّاها التكرار والهلع، فصنعت من الوهم خطرًا حقيقيًا، ومن حادثة موضعية أزمة صحية وطنية.
قصتا سياتل وكولومبيا ليستا استثناءً. في واقعنا العربي، لا يكاد يمر أسبوع إلا وتنتشر قصة أو إشاعة، فتتحول في ساعات إلى "حقيقة" يتداولها الناس، ويُبنى عليها قلق، أو رفض، أو تصرفات قد تكون ضارة. حادثة صحية، شائعة عن منتج غذائي، إشاعة عن شخصية عامة، كلها تبدأ بملاحظة أو تدوينة، ثم تتضخم عبر وسائل التواصل، وتُنتج في النهاية رأيًا جمعيًا يصعب دحضه، لأنه لم ينبنِ على المنطق من الأساس.
في عصر الشبكات، حيث تسبق المشاعرَ الوقائع، وتُشكّل الانطباعاتُ وعيَنا قبل أن نسمع الحقيقة، نحن بحاجة إلى تحصين أنفسنا من عدوى القناعات. لا لأن الناس أغبياء، بل لأن العقول البشرية مبرمجة للاستدلال بما يفعله الآخرون عندما تَشِحّ المعلومات. ولهذا، فإن مقاومة التضليل لا تبدأ بالمعلومة، بل باليقظة. بالسؤال النقدي: هل هذا الرأي نابع من قناعتي، أم من ضجيج المحيط؟
في زمن أصبحت فيه العدوى المعرفية أكثر فتكًا من العدوى البيولوجية، فإن أول خطوة نحو التعافي تكمن في تلك الوقفة العقلية التي تسأل: من أين جاء هذا الاعتقاد؟ هل هو حقًا نابع من فهمي، أم أنه مجرد صدى لما يتردّد حولي؟



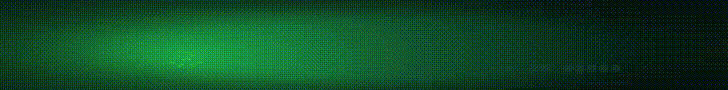

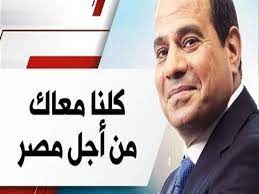
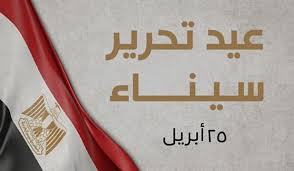

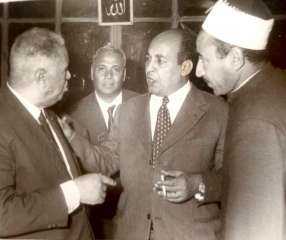










 كارثة جديدة على ”الإقليمي” قرب بني سلامة.. مصرع وإصابة العشرات في تصادم...
كارثة جديدة على ”الإقليمي” قرب بني سلامة.. مصرع وإصابة العشرات في تصادم... جريمة هزت المنوفية أب يعذب نجله صعقا بالكهرباء حتي الموت ...
جريمة هزت المنوفية أب يعذب نجله صعقا بالكهرباء حتي الموت ... انهيار منزل دون اصابات بالخانكة
انهيار منزل دون اصابات بالخانكة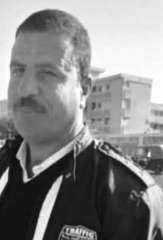 مصرع امين سرطة علي يد سائق دهسه عند ايقافة بشبرا الخيمة
مصرع امين سرطة علي يد سائق دهسه عند ايقافة بشبرا الخيمة انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي (الحمى القلاعية - حمى الوادي...
انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي (الحمى القلاعية - حمى الوادي... الدوسري يهنئ بن الحاج برئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة ويعد بدعم...
الدوسري يهنئ بن الحاج برئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة ويعد بدعم... ثلاث ذهبيات وخمس فضيات لسباحي الكويت في “الخليجية”.. ورقم جديد للطرموم في...
ثلاث ذهبيات وخمس فضيات لسباحي الكويت في “الخليجية”.. ورقم جديد للطرموم في... اليوم انطلاق منافسات بطولة BRAVE CF 97
اليوم انطلاق منافسات بطولة BRAVE CF 97